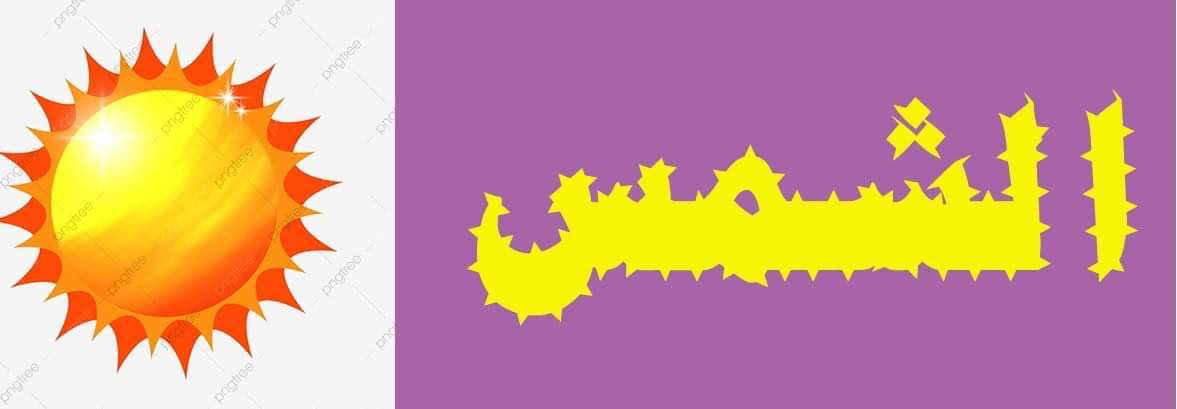حين يصبح التنوع الإثني والعرقي لعنة... السودان من التعدد الثقافي إلى الحروب الاعلاميه امل عبد الحميد السودان
حين يصبح التنوع الإثني والعرقي لعنة... السودان من التعدد الثقافي إلى الحروب
لم يدرك السودانيون أن جدل الهوية الذي عجزت النخب السياسية منذ الاستقلال عن معالجته، ببناء هوية وطنية جامعة، يمكن أن يقود إلى واقع مرير محصلته فشل إدارة التنوع ونشوب حرب أهلية اندلعت منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023. فما بين يومٍ وليلة وجد كثير من السودانيين أنفسهم مشردين بلا مأوى، في ظل ظروف إنسانية قاسية، عصفت بمعظم الناجين من الموت ليصبحوا إما نازحين -تخطى عددهم 10 ملايين داخل ولايات السودان المختلفة- أو لاجئين يقدروا بمليونين فروا إلى دول الجوار، لينضموا إلى بقية شعوب الشتات.
السودان الدولة ذات الموقع الجيوسياسي المميز والمساحات الشاسعة والموارد الغنية، شهدت منذ عصور ما قبل التاريخ تحركات سكانية دون انقطاع، وتنقلت في أراضيه مجموعات متنوعة إثنية ودينية وثقافية، لسهولة الارتحال إليه، ولمجاورته العديد من الدول، ولانتشار حرفة الرعي التي لا تقيد الجماعات السكانية بالأرض التي تعيش عليها.
استقرت السلالات القوقازية في شماله والزنجية في جنوبه، بينما تسرّبت الهجرات العربية بعد ظهور الإسلام عبر موانئ البحر الأحمر وصحراء سيناء ونهر النيل. وقد تعايشت كل هذه المجموعات العرقية المختلفة وتزاوجت فيما بينها، وذابت القبائل في بعضها، وامتزجت امتزاجًا يعجز المرء عند تأمله عن تمييز من هو العربي ممن هو الزنجي، وانصهرت في بوتقة واحدة مكونة شعب السودان.
يقول الدكتور أسامة أحمد المصطفى الكاتب والمحلل في الشؤون الأفريقية: " إن التنوع الثقافي والاثني واللغوي لا يعد مهدد لأمن الشعوب واستقرار الدول، بقدر ما أصبحت الدولة هي المهدد لاندماج ووحدة التنوع، لاستغلال الأنظمة السياسية لهذا التنوع لبلوغ غاياتها وتحقيق أهدافها". ويضيف بأن الدولة السودانية راهنت على انفرادها بالسلطة عبر معادلة تستند على تعددية مقيدة ومصطنعة يتم تركيبها من جماعات تختارها السلطة وتفرضها على الشعب دون أن تعترف بوجود أزمة خطيرة ومعقدة، نتاجها ما نحن فيه الآن الحرب الدائرة بالبلاد منذ أكثر من عام.
تناقضات الحركة الوطنية والاستقلال
منذ نشأته الأولى، ساد في السودان نظام الممالك، التي اتسمت بالاستقلال الذاتي، إلى أن خضع للحكم التركي، ومن بعده الحكم الثنائي (المصري - البريطاني)، الذي طبق سياسة (فَرِّق تَسُدْ)، أو ثنائية المركز والهامش، ووسعت إنجلترا نفوذها الاستعماري ببذر بذور الشقاق، ومنح مشائخ القبائل والسلاطين نفوذاً إدارياً واسعاً، لإذكاء روح الصراع وإخضاع البلاد لسياسة التقسيم، كما طبقت سياسة تعميق التباعد، بعزل الشمال عن الجنوب، بفرضها قانون المناطق المقفولة، وإسناد التعليم إلى البعثات المسيحية (التبشيرية)، لخلق صفوة متعلمة ومشبعة بروح الحضارة الغربية، وحاربت اللغة العربية والإسلام، كل هذه السياسات ساهمت في توسيع الهوة بين الشماليين والجنوبيين.
لعبت الزعامات القبلية دوراً هاماً في مسار التعايش السلمي بعد الاستقلال، الذي كان الأولوية في مناطق التماس بين المجموعات العرقية المختلفة، ومع غياب هذه القيادات الحكيمة، غابت مواريث التعايش السلمي وإدارة التنوع وانفرط العقد على أسس إثنية وعرقية وأيديولوجية، لتدخل البلاد في نفق مظلم.
وبالرغم من الاختلاف الأيديولوجي والسياسي للأحزاب لكنها قادت السودان إلى الاستقلال. تماسك السودانيون واتحدوا لتقرير مصيرهم وتجاوزوا خلافاتهم، لمحاربة الهيمنة الخارجية وقوى الاستعمار. تكونت الحركة الوطنية من مجموعات متناقضة، شملت الأحزاب الطائفية والاتحادات الطلابية والنسوية والعمال والمجموعات القبلية والتجمعات التجارية والمهنية، اتفقت جميعها بكل تناقضاتها على تحقيق إرادة الشعب السوداني، لنيل الاستقلال في العام 1956.
لعبت الزعامات القبلية وقتها دوراً هاماً في مسار التعايش السلمي، الذي كان الأولوية في مناطق التماس بين المجموعات العرقية المختلفة، وساهم في امتصاص الغضب وتقليل الاحتكاك القبلي. ومع غياب هذه القيادات الحكيمة، غابت مواريث التعايش السلمي وإدارة التنوع وانفرط العقد على أسس إثنية وعرقية وأيديولوجية، لتدخل البلاد في نفق مظلم.
ويوصف الدكتور الواثق كمير المحلل السياسي نزاع القوى الوطنية عقب الاستقلال بقوله: ما أن انطلقت العملية السياسية لتأسيس الدولة الوطنية المستقلة حتى نشب الصراع على سلطة الدولة الوليدة بين أحزاب القوى التقليدية والإسلامية، من ناحية، وبينها وبين القوى الحديثة من ناحية أخرى، والذي أفضى إلى إنقلاب واستلام الجيش للسلطة في 1958 و1969 و1989، تحت غطاء سياسي لأطراف كل هذه القوى. ظلت فترة ما بعد الاستقلال تشهد صراعاً داخلياً بين مختلف القوى السياسية الوطنية، التي توحدت في النضال ضد المُستعمِر، حول السلطة الوطنية ومهام بناء الدولة، وهو الصراع الذي لا يزال مستمراً، ولو تعددت أطرافه واختلفت أشكاله.
ثقافة إقصاء الآخر وإخفاق النخب السياسية
تميز التاريخ السياسي في السودان عقب الاستقلال بتكريس السلطة المركزية والنفوذ، لقلة من المجموعات السكانية الشمالية على امتداد نهر النيل، وهو ما مهّدت له سياسات الاستعمار وتعاقبت الانقلابات العسكرية والحروب على البلاد، وخرجت خلالها القبلية عن سياقها المعتاد، واسُتخدمت في غير مقاصدها، مما أحدث اختلال وفجوة اجتماعية عميقة، نتيجة التوزيع غير العادل للموارد وعدم التوازن والمساواة في اقتسام الدخل القومي.
وظهرت شعارات فكرية وسياسية عديدة عقب الاستقلال (الزنوجة والعروبة، الأفريقانية والعروبية، المسيحية والإسلام، الجنوب والشمال، الهامش والمركز، والسودانوية)، وكان للنخب السياسية النصيب الأوفر في تبني هذه الأفكار، التي ساهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي، ودأبت على التهميش والإقصاء الممنهج لبقية المكونات الاجتماعية في بقية مناطق السودان، ونتج عنها استبعادهم وتقليل دورهم في الحياة السياسية.
أخفقت النخب السياسية التي تولت مقاليد الحكم في بناء هوية وطنية جامعة، تستوعب هذا التنوع والاختلاف، وتميزت سياستها بتعمد تكريس سياسة التمييز لهويات فرعية، تعزز وجودها واستمرارها في السلطة وفقا لمصالحها الضيقة. وأصاب الأحزاب السياسية الطائفية الوهن والضعف، جراء الانقلابات العسكرية المتوالية على البلاد، وكانت الانشقاقات والانقسامات ديدنها، فانصرفت إلى الكيد والنزاع بدلاً من تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين.
ويشير الدكتور أسامة أحمد المصطفى في مقابلة مع رصيف22، إلى أن الميراث الاستعماري في السودان كان مسؤولاً إلى حد بعيد عن خلق منطقة مركزية مهيمنة ومحيطات خارجية، حيث تسببت الخطة الاستعمارية لرسم حدود الدول في خلق مشاكل جمة للسودان، وعقب الاستقلال برزت عدة مستويات من التناقض بين النخبة الحاكمة والمحيط الخارجي، فبينما كان نشوء معظم العوامل الأساسية متأصل في التراث الاستعماري، كانت العوامل الثانوية في المقابل متأصلة في السياسات الخاطئة والمضللة، التي استنبطتها وطبقتها النخبة السياسية باعتبارها انعكاس لوجهة النظر الرسمية لدولة السودان خاصة فيما يتعلق بالجنوب.
ظهرت شعارات فكرية وسياسية عديدة عقب الاستقلال مثل الزنوجة والعروبة، الأفريقانية والعروبية، المسيحية والإسلام، الجنوب والشمال، الهامش والمركز، والسودانوية.
ويؤكد أسامة أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والانهيار الاقتصادي في جنوب السودان ليس هو السبب الرئيسي الذي غذى أفكار فصل جنوب السودان، وهو الوضع الغالب لمعظم أقاليم السودان آنذاك، إذا تجاوزنا العامل النفسي التاريخي الذي تغذيه روح القبيلة وسياسة فرق تسد، لافتاً إلى أن السبب الأكثر أهمية في معضلة جنوب السودان هو سبب معرفي وأكاديمي يتضح بجلاء في كتابات دعاة الانفصال بالدراسات السودانية المتعلقة بجنوب السودان في ظل انعدام الحريات الديمقراطية، وظروف القهر التي سادت في أعقاب ديكتاتوريات متتالية امتدت لأكثر من ست عقود.
وفي تموز/ يوليو 2011 عجلت سياسات التمييز وسوء إدارة التنوع الثقافي والاثني التي تبنتها الدولة من انفصال جنوب السودان، وفقد السودان وقتها لقب الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والوطن العربي، بعد ما فقد ربع مساحته نتيجة خوض حرب أهلية طاحنة، تعتبر من أطول وأعنف حروب القرن، دامت لأكثر من ستين عام، لقى خلالها ما يقارب 1.5 مليون شخص حتفهم، وشُرد أكثر من أربعة ملايين شخص.
لم يكن انفصال جنوب السودان خاتمة المطاف لأزمات السودان، إنما كان بداية النهاية لمرحلة التشظي واشتعال بؤر الصراع في كل أقاليم السودان. وكان للتدخل الأجنبي السافر في قضية جنوب السودان ومن بعدها نزاع دارفور، دورا مؤثرا في تفاقم الأوضاع، حيث دعمت القوى الإقليمية والدولية الصفوة من أبناء الجنوب ودارفور مادياً وسياسياً وإعلامياً، رغبة في زعزعة استقرار السودان، واتخذت من الهوية المدخل لتحقيق أجندتها وإضعاف الوحدة الوطنية في السودان.
سيطرة العسكر على الحكم
شهد السودان تاريخ حافل من الانقلابات العسكرية منذ نيله الاستقلال، نجح بعضها وفشل معظمها، وزُج ببعض منفذيها في غياهب السجون، وعُلق آخرين في المشانق. كانت وراء غالبية هذه الانقلابات العسكرية، أجندة سياسية لجماعات حزبية ودوائر أجنبية إقليمية ودولية. ويقع وزر التخبط الذي عاشه السودان، ما بين النظم الشمولية والديمقراطيات المجهضة، على عاتق الأحزاب والنخب السياسية، حين باعت ولائها للقوات المسلحة، وخيبت أمال الشعب لضعفها واخفاقها في تنفيذ وعودها التي قطعتها عند الاستقلال. بينما يقع على القيادة العسكرية التي قادت الانقلابات طمعا في السلطة، تضيعها فرص تحقيق الأمن والسلام، وتجنيب البلاد النزاع والتناحر والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
بحسب الدكتور حسن الحاج علي أستاذ العلوم السياسية والباحث بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، تتشابه الأنظمة المدنية والعسكرية التي حكمت البلاد في أنها عانت مشاكل الهشاشة وعدم الاستقرار السياسي، على الرغم من ذلك فهي تأتي إلى السلطة في أوضاع مختلفة؛ فحين يستلم العسكريون السلطة فإنّهم يفعلون ذلك وسط حالة من الانقسام والتصدع السياسي، وهو ما حدث في الفترات التي سبقت الانقلابات العسكرية. أما المدنيون فيأتون إلى السلطة في بيئة من التوافق النسبي على هيكل العمل السياسي وقواعده يستغل العسكريون حالة التصدع السياسي وتعاقب الحكومات الائتلافية لعكس فشل المدنيين وتبرير الانقلاب على أنه عمل وطني يرمي إلى إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتفكك يتسلّم المدنيون الحكم، في الغالب، بعد أن يعزل النظام العسكري نفسه من حلفائه المدنيين.
ويؤكد الحاج بأن أغلب الفاعلين السياسيين يصلون إلى نتيجة مفادها بأنّ النظام العسكري ليس آلية فعالة لتحقيق مصالحهم، فيتبنون ما يشبه الإجماع السياسي بينهم مفاده أن إزالة النظام العسكري أفضل الطرق لخدمة مصالحهم.
ومن خلال قراءة أحداث النزاعات العرقية في أقاليم السودان المختلفة في العقود الأخيرة، لم يكن انقلاب الرئيس السابق عمر البشير في يونيو 1989، محض قرار عسكري، إنما تدخل سياسي أيديولوجي بالتعاون مع الحركة الإسلامية، حين أخفت دوافعها عند استلامها السلطة، وأفصحت عنها بعد بضعة أشهر من انقلابها، عندما وضعت تصورها لبناء الدولة على أساس ديني، واستهدفت إحداث تغيير في التعليم والصحة والجيش وتحرير الاقتصاد وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وإقصاء غير المسلمين والموالين لفكرها في دواوين الخدمة المدنية. حيث قامت بفصل الآلاف من الموظفين وفقا لقانون أطلقت عليه "قانون الصالح العام"، كما فرضت التجنيد الإجباري، وأصدرت قانون الدفاع الشعبي، لتشكيل قوات عسكرية هي بمثابة مليشيا حزبية، تم الاعتماد عليها في محاربة التمرد في جنوب السودان، مما فاقم من أزمة الجنوب، وأجج اشتعال النزاع ومنحته بُعد أيديولوجي. وكان لأقاليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة النصيب الأوفر من الجرائم ضد الإنسانية.
نزاع دارفور
تنوع بيئي وبشري وتفرد حضاري، بعض مما يميز إقليم دارفور الذي يعتبر صورة مصغرة للسودان. هذا الإقليم المعروف بتركيبته الإثنية المعقدة، وهي خليط مجموعات أفريقية وعربية، لكنها اتسمت بالتعايش السلمي، لحرص زعماء وحكماء القبائل في الإدارة الأهلية، على تقليص الهوة بين المجموعات القبلية، بهدف ترسيخ أسس التسامح والسلام.
وحسب الدكتور محجوب محمد أدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فإن الإدارة الأهلية لعبت دوراً كبيراً في رتق النسيج الاجتماعي وإعلاء القيم الوطنية وتعضيد الاستقرار خاصة في الأماكن النائية من البلاد والتي يصعب الوصول إليها من أجهزة الدولة المعنية، لافتاً إلى أنها ظلت سنداً للأجهزة العدلية والأمنية وساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة قيم السلام بين قبائل دارفور.
وقد تعرضت دارفور خلال العقود الأخيرة إلى تفاقم ظاهرة الجفاف والتصحر، مما زاد من حالات التوتر بين السكان المحليين المعتمدين على الزراعة، والرُحل المعتمدين على الرعي. وارتفعت وتيرة الصراع، لتدفق السلاح من الداخل والخارج، لخدمة النزاع العرقي والايديولوجي الدائر في الإقليم، ساهم في ذلك العزلة الجغرافية والاجتماعية التي عاشتها دارفور منذ الاستقلال، لتجاهل الحكومات المتعاقبة للمنطقة مما يكرس الفوارق الإثنية. ارتبطت دارفور بالمناطق المتاخمة لها داخلياً كردفان وبحر الغزال، بينما ارتبطت خارجياً بدولتي تشاد وليبيا، عزز كل هذا عزلتها عن بقية أقاليم السودان، وفي ظل هذه العزلة أصبحت القبيلة هي المرجعية الأساسية.
بلغت وتيرة النزاع أشدها في العام 2003، عندما هاجمت الحركات المسلحة مناطق الحكومة السودانية، لاتهامها باضطهاد ذوي الأصول الأفريقية. وحشدت حكومة نظام البشير مجموعات إثنية مسلحة، ما يسمى مليشيات الجنجويد من ذوي الأصول العربية، لصد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتهجير ما يزيد عن مليونين، ولجوء نحو 400 ألف شخص إلى المخيمات في دولة تشاد.
لم يكن انقلاب الرئيس السابق عمر البشير في يونيو 1989، محض قرار عسكري، إنما تدخل سياسي أيديولوجي بالتعاون مع الحركة الإسلامية، حين أخفت دوافعها عند استلامها السلطة، وأفصحت عنها بعد بضعة أشهر من انقلابها
في أعقاب ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية وإبادة جماعية ضد المدنيين بدارفور.
مؤخرا أدى اندلاع القتال المفاجئ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تصاعد العنف في إقليم دارفور، وارتكبت مليشيات الدعم السريع والمليشيات العربية الأخرى أعمال قتل واسعة ضد المدنيين، وتصاعد العنف الجنسي ونهبت وأحرقت العديد من القرى والمخيمات، كما استهدفت بالقتل القادة المحليين والعاملين في منظمات دولية.
انفراط العقد
لعل السودان الدولة الأكثر تعقيدًا في أفريقيا من حيث التركيبة السكانية، وفقاً لأول تعداد سكاني تم إجراؤه قبل نصف قرن، فإن هناك أكثر من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قبيلة وعشيرة. بالرغم من أن التعدد الإثني هو قَدَر أهل السودان، وأساس النسيج الاجتماعي والثقافي السوداني، ولكن وحدة الهدف والمصير أعمق المكونات الاجتماعية؛ إلا أنها فشلت في جمع هذه المجموعات العرقية لإدارة تنوع ناجح.
ويحلل الدكتور أسامة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة التنوع بقوله: "في الواقع فالتفاوت في التنمية والفرص غير المتكافئة في تقاسم السلطة والثروة بين أقاليم السودان أشاع مشاعر قوية معادية للشماليين في بقية مناطق السودان، وقادت هذه المشاعر إلى حركات إقليمية مناهضة للدولة في دارفور وكردفان وشرق السودان بسبب المحسوبية والقبلية والإثنية فجاءت ردود أفعالهم كجزء طبيعي لفقدانهم هذا النفوذ". مما ساهم في المأزق السياسي وانقسام البلاد، وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية.
وكان يمكن للنخب الحاكمة أن تلعب دوراً فاعلاً في توحيد هذا الهدف، وصياغة مفهوم الوحدة الوطنية، وتحويله إلى مشروع سياسي؛ لكنها عمقت الخلاف حول مقومات الوحدة الوطنية، من وحدة اللغة والدين والعرق على مرور الحقب التاريخية، وتهاونت الحكومات الوطنية في جمع شتات الأقليات الإثنية، وفرطت في احترام الفوارق وتطبيق العدل والمساواة وقللت من تعزيز قيم التسامح، لتفشل بذلك الدولة السودانية، وتحصد ثمار ما زرعته من الانقسام والتشتت والحروب.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أثر الأطراف الدولية والإقليمية على هذه الوحدة منذ الاستقلال، بممارسة الضغط من خلال دعم الحركات المسلحة، لتعزيز انفراط عقد البلاد. وكان لها اليد الطولى في تفتيت السودان، وتدويل الصراع بخروجه من الإطار المحلي، ليصبح قضية رأي عالمي.
سيطرة العقل الجمعي
ارتبط الطرح الثقافي لموضوع الهوية، وصلتها بالعرق والقبلية في السودان بالعقل الجمعي للمجتمعات التي تشترك في خصائص الأرض والجغرافية والتاريخ والبيئة والتراث والفكر والوجدان. وظل معنى الهوية الإثنية والأقليات العرقية والدينية ينبثق من جذور مجتمعية وثقافة شعبية سودانية، كانت من الثوابت الراسخة عبر الحقبة التاريخية.
تجذرت هذه الثقافة طوعاً واختياراً بمرور الزمن، وأصبح الفعل الاجتماعي محكوم بالعقل الجمعي، بينما كان السلوك والتفكير تحت سطوة مؤسسات الدولة التقليدية، والتي اتجهت نحو النهج الفوقي، بالانحياز إلى العنصر العربي الإسلامي، وقد بدأ ظهور معنى الهوية أبان الممالك والسلطنات الإسلامية، حين نشأتها في القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، عقب تداخل العناصر العربية والأفريقية.
لعل السودان الدولة الأكثر تعقيدًا في أفريقيا من حيث التركيبة السكانية، وفقاً لأول تعداد سكاني تم إجراؤه قبل نصف قرن، فإن هناك أكثر من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قبيلة وعشيرة
كرست الثقافة الشعبية، تعامل مجتمع المركز والحضر مع أزمة النزاع وارتكاب جرائم تطهير عرقي في مجتمعات الهامش برد فعلى اجتماعي، تكسوه القسوة والاستبداد والعنصرية والتغافل عن الأحداث الدائرة فيها. والمرجع لهذا التعالي، هو ترسيخ الدولة لثقافة إقصاء الإثنيات العرقية في الأقاليم المهمشة، ليظل الوعي الجمعي مغيب وغير مدرك بأن النقاء العرقي وما يتصل به من تقسيم هو مجرد وهم.
الكاتب الصحافي والروائي فايز الشيخ السليك، يربط ما بين الأزمات المتتالية في السودان والعقل الجمعي في مقدمة كتابه " الزلزال .. العقل السوداني ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب " بقوله: إن المشكلة هي في (العقل الجمعي)، وإن لكل مجتمع خصائصه، وبصماته، وهي محصلة لمكونات ثقافية، وبيئية، وجينية، تجعله يُفكر، وفق إحداثيات هذه المرجعية، فوطن يتقسم، وأزمة مزمنة تحاصر ما تبقى من وطن، ومع كل ذلك يلفنا السكون، وكلما لاح وميض ضوء في آخر النفق، سرعان ما ينطفئ هذا البريق، ويختبئ هذا الوميض، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سر اضطراب دورات الحكم في بلادنا، وتقلبات الأنظمة السياسية، وركود الأحوال الاجتماعية، وفشلنا في استغلال مواردنا الطبيعية الثرة التي يزخر بها السودان، إن كل ذلك يؤكد وجود مشكلة بنيوية، مرتبطة بطبيعة تكويننا النفسي والثقافي والذهني، وانعكاسات ذلك على تصوراتنا حول الكون، والناس والأشياء، وأنفسنا والآخرين.
بروباغندا حرب السودان
ترجع جذور الصراع الدائر حاليًا بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى توظيف حكومة نظام عمر البشير السابق، لمفهوم العروبة والإسلام في استقطاب القبائل لتأييد حكمه، وإنشاء فصائل شبه عسكرية للقضاء على تمرد الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وهو ما نتج عنه حالة النزاع والتناحر العرقي في إقليم دارفور منذ العام 2003.
لم تتورع "مليشيات" الدعم السريع عن قتل المدنيين في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنار التي سيطرت عليها مؤخراً، وقامت بنهبهم واستخدمتهم كدروع بشرية، واحتجزت العديد من الأسرى، واغتصبت النساء، واستهدفت الشباب بالتجنيد القسري، وأرغمتهم على القتال
عقب تكوين هذه القوات، اعترفت الحكومة رسميا بها في العام 2013، وأصبحت قوات الدعم السريع موازية للجيش الوطني السوداني، تلاها إجازة البرلمان السوداني مشروع (قانون الدعم السريع) في يناير 2017، بإجماع نوابه على أن تتبع للجيش السوداني، بعد ما كانت تنضوي تحت لواء الأمن والمخابرات، بالرغم من أن تكوينها كان على أسس عرقية وأنها امتداد ( لمليشيات الجنجويد).
لمع محمد حمدان دقلو " حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، الذي ورث قيادة الجنجويد من قائدها موسى هلال، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019. أعقب ذلك تولي عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة، وتكليف حميدتي نائباً له. شكل البرهان وحميدتي قوة ضاربة تجاه القوى المدنية وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلنا انقلاب أطاح بالمدنيين.
لكن هذه العلاقة الوطيدة لم يقدر لها الاستمرار، فقد اتسعت الهوة بين الرجلين، بعد الإقرار بفشل الانقلاب على القوى المدنية، وتوقيع اتفاق إطاري مع المدنيين، يقضي باستعادة الانتقال المدني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. إلا أن نُذر الخلاف ظهرت على عدد سنوات الدمج، واتهام حميدتي لقائد الجيش بالعمل على عودة الإسلاميين إلى السلطة، ليصل الاختلاف إلى حافة هاوية الحرب، التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وامتدت لتعم غالبية ولايات السودان، واجتذبت أطراف أخرى، بما في ذلك الحركات المسلحة والمليشيات القبلية.
لم تتورع "مليشيات" الدعم السريع من ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاوزات بشعة بحق المدنيين في الولايات التي استولت عليها، فقد عمدت إلى قتل المدنيين في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنار التي سيطرت عليها مؤخراً، وقامت بنهبهم واستخدمتهم كدروع بشرية، واحتجزت العديد من الأسرى، واغتصبت النساء، واستهدفت الشباب بالتجنيد القسري، وأرغمتهم على القتال. كما احتلت معظم المستشفيات والمرافق الخدمية، وقامت بهدم وقصف وتدمير البنية التحتية، والمنشآت العامة، ومساكن المواطنين.
وفي دارفور ارتكبت إبادة جماعية، ضد جماعة المساليت الإثنية الأفريقية في ولاية غرب دارفور، وسيطرت على مدينة مليط وحاصرت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وهجرَّت واغتالت العديد من سكانها، ورفضت دخول المساعدات الإنسانية لهذه المدن.
إن المشهد الحالي لأزمة السودان لا يُحتمل، ومن المهم بمكان تحرك الرأي العام العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تستخدم البروباغندا والوسائل الدعائية في حرب السودان لمصالحها الضيقة، فهي تحذر وتدين وتتقصى، ولكنها فشلت في تحمل المسؤولية، بمنع وقوع المزيد من الفظائع، وتدارك الكارثة الإنسانية، وتوجيه الأنظار نحو ارتكاب جرائم وحشية وتطهير عرقي للسودانيين.
إن العالم يتجاهل السودان ويدرك حقيقة ما وراء هذه الحرب ولكنه لا يكترث لها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لم يدرك السودانيون أن جدل الهوية الذي عجزت النخب السياسية منذ الاستقلال عن معالجته، ببناء هوية وطنية جامعة، يمكن أن يقود إلى واقع مرير محصلته فشل إدارة التنوع ونشوب حرب أهلية اندلعت منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023. فما بين يومٍ وليلة وجد كثير من السودانيين أنفسهم مشردين بلا مأوى، في ظل ظروف إنسانية قاسية، عصفت بمعظم الناجين من الموت ليصبحوا إما نازحين -تخطى عددهم 10 ملايين داخل ولايات السودان المختلفة- أو لاجئين يقدروا بمليونين فروا إلى دول الجوار، لينضموا إلى بقية شعوب الشتات.
السودان الدولة ذات الموقع الجيوسياسي المميز والمساحات الشاسعة والموارد الغنية، شهدت منذ عصور ما قبل التاريخ تحركات سكانية دون انقطاع، وتنقلت في أراضيه مجموعات متنوعة إثنية ودينية وثقافية، لسهولة الارتحال إليه، ولمجاورته العديد من الدول، ولانتشار حرفة الرعي التي لا تقيد الجماعات السكانية بالأرض التي تعيش عليها.
استقرت السلالات القوقازية في شماله والزنجية في جنوبه، بينما تسرّبت الهجرات العربية بعد ظهور الإسلام عبر موانئ البحر الأحمر وصحراء سيناء ونهر النيل. وقد تعايشت كل هذه المجموعات العرقية المختلفة وتزاوجت فيما بينها، وذابت القبائل في بعضها، وامتزجت امتزاجًا يعجز المرء عند تأمله عن تمييز من هو العربي ممن هو الزنجي، وانصهرت في بوتقة واحدة مكونة شعب السودان.
يقول الدكتور أسامة أحمد المصطفى الكاتب والمحلل في الشؤون الأفريقية: " إن التنوع الثقافي والاثني واللغوي لا يعد مهدد لأمن الشعوب واستقرار الدول، بقدر ما أصبحت الدولة هي المهدد لاندماج ووحدة التنوع، لاستغلال الأنظمة السياسية لهذا التنوع لبلوغ غاياتها وتحقيق أهدافها". ويضيف بأن الدولة السودانية راهنت على انفرادها بالسلطة عبر معادلة تستند على تعددية مقيدة ومصطنعة يتم تركيبها من جماعات تختارها السلطة وتفرضها على الشعب دون أن تعترف بوجود أزمة خطيرة ومعقدة، نتاجها ما نحن فيه الآن الحرب الدائرة بالبلاد منذ أكثر من عام.
تناقضات الحركة الوطنية والاستقلال
منذ نشأته الأولى، ساد في السودان نظام الممالك، التي اتسمت بالاستقلال الذاتي، إلى أن خضع للحكم التركي، ومن بعده الحكم الثنائي (المصري - البريطاني)، الذي طبق سياسة (فَرِّق تَسُدْ)، أو ثنائية المركز والهامش، ووسعت إنجلترا نفوذها الاستعماري ببذر بذور الشقاق، ومنح مشائخ القبائل والسلاطين نفوذاً إدارياً واسعاً، لإذكاء روح الصراع وإخضاع البلاد لسياسة التقسيم، كما طبقت سياسة تعميق التباعد، بعزل الشمال عن الجنوب، بفرضها قانون المناطق المقفولة، وإسناد التعليم إلى البعثات المسيحية (التبشيرية)، لخلق صفوة متعلمة ومشبعة بروح الحضارة الغربية، وحاربت اللغة العربية والإسلام، كل هذه السياسات ساهمت في توسيع الهوة بين الشماليين والجنوبيين.
لعبت الزعامات القبلية دوراً هاماً في مسار التعايش السلمي بعد الاستقلال، الذي كان الأولوية في مناطق التماس بين المجموعات العرقية المختلفة، ومع غياب هذه القيادات الحكيمة، غابت مواريث التعايش السلمي وإدارة التنوع وانفرط العقد على أسس إثنية وعرقية وأيديولوجية، لتدخل البلاد في نفق مظلم.
وبالرغم من الاختلاف الأيديولوجي والسياسي للأحزاب لكنها قادت السودان إلى الاستقلال. تماسك السودانيون واتحدوا لتقرير مصيرهم وتجاوزوا خلافاتهم، لمحاربة الهيمنة الخارجية وقوى الاستعمار. تكونت الحركة الوطنية من مجموعات متناقضة، شملت الأحزاب الطائفية والاتحادات الطلابية والنسوية والعمال والمجموعات القبلية والتجمعات التجارية والمهنية، اتفقت جميعها بكل تناقضاتها على تحقيق إرادة الشعب السوداني، لنيل الاستقلال في العام 1956.
لعبت الزعامات القبلية وقتها دوراً هاماً في مسار التعايش السلمي، الذي كان الأولوية في مناطق التماس بين المجموعات العرقية المختلفة، وساهم في امتصاص الغضب وتقليل الاحتكاك القبلي. ومع غياب هذه القيادات الحكيمة، غابت مواريث التعايش السلمي وإدارة التنوع وانفرط العقد على أسس إثنية وعرقية وأيديولوجية، لتدخل البلاد في نفق مظلم.
ويوصف الدكتور الواثق كمير المحلل السياسي نزاع القوى الوطنية عقب الاستقلال بقوله: ما أن انطلقت العملية السياسية لتأسيس الدولة الوطنية المستقلة حتى نشب الصراع على سلطة الدولة الوليدة بين أحزاب القوى التقليدية والإسلامية، من ناحية، وبينها وبين القوى الحديثة من ناحية أخرى، والذي أفضى إلى إنقلاب واستلام الجيش للسلطة في 1958 و1969 و1989، تحت غطاء سياسي لأطراف كل هذه القوى. ظلت فترة ما بعد الاستقلال تشهد صراعاً داخلياً بين مختلف القوى السياسية الوطنية، التي توحدت في النضال ضد المُستعمِر، حول السلطة الوطنية ومهام بناء الدولة، وهو الصراع الذي لا يزال مستمراً، ولو تعددت أطرافه واختلفت أشكاله.
ثقافة إقصاء الآخر وإخفاق النخب السياسية
تميز التاريخ السياسي في السودان عقب الاستقلال بتكريس السلطة المركزية والنفوذ، لقلة من المجموعات السكانية الشمالية على امتداد نهر النيل، وهو ما مهّدت له سياسات الاستعمار وتعاقبت الانقلابات العسكرية والحروب على البلاد، وخرجت خلالها القبلية عن سياقها المعتاد، واسُتخدمت في غير مقاصدها، مما أحدث اختلال وفجوة اجتماعية عميقة، نتيجة التوزيع غير العادل للموارد وعدم التوازن والمساواة في اقتسام الدخل القومي.
وظهرت شعارات فكرية وسياسية عديدة عقب الاستقلال (الزنوجة والعروبة، الأفريقانية والعروبية، المسيحية والإسلام، الجنوب والشمال، الهامش والمركز، والسودانوية)، وكان للنخب السياسية النصيب الأوفر في تبني هذه الأفكار، التي ساهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي، ودأبت على التهميش والإقصاء الممنهج لبقية المكونات الاجتماعية في بقية مناطق السودان، ونتج عنها استبعادهم وتقليل دورهم في الحياة السياسية.
أخفقت النخب السياسية التي تولت مقاليد الحكم في بناء هوية وطنية جامعة، تستوعب هذا التنوع والاختلاف، وتميزت سياستها بتعمد تكريس سياسة التمييز لهويات فرعية، تعزز وجودها واستمرارها في السلطة وفقا لمصالحها الضيقة. وأصاب الأحزاب السياسية الطائفية الوهن والضعف، جراء الانقلابات العسكرية المتوالية على البلاد، وكانت الانشقاقات والانقسامات ديدنها، فانصرفت إلى الكيد والنزاع بدلاً من تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين.
ويشير الدكتور أسامة أحمد المصطفى في مقابلة مع رصيف22، إلى أن الميراث الاستعماري في السودان كان مسؤولاً إلى حد بعيد عن خلق منطقة مركزية مهيمنة ومحيطات خارجية، حيث تسببت الخطة الاستعمارية لرسم حدود الدول في خلق مشاكل جمة للسودان، وعقب الاستقلال برزت عدة مستويات من التناقض بين النخبة الحاكمة والمحيط الخارجي، فبينما كان نشوء معظم العوامل الأساسية متأصل في التراث الاستعماري، كانت العوامل الثانوية في المقابل متأصلة في السياسات الخاطئة والمضللة، التي استنبطتها وطبقتها النخبة السياسية باعتبارها انعكاس لوجهة النظر الرسمية لدولة السودان خاصة فيما يتعلق بالجنوب.
ظهرت شعارات فكرية وسياسية عديدة عقب الاستقلال مثل الزنوجة والعروبة، الأفريقانية والعروبية، المسيحية والإسلام، الجنوب والشمال، الهامش والمركز، والسودانوية.
ويؤكد أسامة أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والانهيار الاقتصادي في جنوب السودان ليس هو السبب الرئيسي الذي غذى أفكار فصل جنوب السودان، وهو الوضع الغالب لمعظم أقاليم السودان آنذاك، إذا تجاوزنا العامل النفسي التاريخي الذي تغذيه روح القبيلة وسياسة فرق تسد، لافتاً إلى أن السبب الأكثر أهمية في معضلة جنوب السودان هو سبب معرفي وأكاديمي يتضح بجلاء في كتابات دعاة الانفصال بالدراسات السودانية المتعلقة بجنوب السودان في ظل انعدام الحريات الديمقراطية، وظروف القهر التي سادت في أعقاب ديكتاتوريات متتالية امتدت لأكثر من ست عقود.
وفي تموز/ يوليو 2011 عجلت سياسات التمييز وسوء إدارة التنوع الثقافي والاثني التي تبنتها الدولة من انفصال جنوب السودان، وفقد السودان وقتها لقب الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والوطن العربي، بعد ما فقد ربع مساحته نتيجة خوض حرب أهلية طاحنة، تعتبر من أطول وأعنف حروب القرن، دامت لأكثر من ستين عام، لقى خلالها ما يقارب 1.5 مليون شخص حتفهم، وشُرد أكثر من أربعة ملايين شخص.
لم يكن انفصال جنوب السودان خاتمة المطاف لأزمات السودان، إنما كان بداية النهاية لمرحلة التشظي واشتعال بؤر الصراع في كل أقاليم السودان. وكان للتدخل الأجنبي السافر في قضية جنوب السودان ومن بعدها نزاع دارفور، دورا مؤثرا في تفاقم الأوضاع، حيث دعمت القوى الإقليمية والدولية الصفوة من أبناء الجنوب ودارفور مادياً وسياسياً وإعلامياً، رغبة في زعزعة استقرار السودان، واتخذت من الهوية المدخل لتحقيق أجندتها وإضعاف الوحدة الوطنية في السودان.
سيطرة العسكر على الحكم
شهد السودان تاريخ حافل من الانقلابات العسكرية منذ نيله الاستقلال، نجح بعضها وفشل معظمها، وزُج ببعض منفذيها في غياهب السجون، وعُلق آخرين في المشانق. كانت وراء غالبية هذه الانقلابات العسكرية، أجندة سياسية لجماعات حزبية ودوائر أجنبية إقليمية ودولية. ويقع وزر التخبط الذي عاشه السودان، ما بين النظم الشمولية والديمقراطيات المجهضة، على عاتق الأحزاب والنخب السياسية، حين باعت ولائها للقوات المسلحة، وخيبت أمال الشعب لضعفها واخفاقها في تنفيذ وعودها التي قطعتها عند الاستقلال. بينما يقع على القيادة العسكرية التي قادت الانقلابات طمعا في السلطة، تضيعها فرص تحقيق الأمن والسلام، وتجنيب البلاد النزاع والتناحر والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
بحسب الدكتور حسن الحاج علي أستاذ العلوم السياسية والباحث بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، تتشابه الأنظمة المدنية والعسكرية التي حكمت البلاد في أنها عانت مشاكل الهشاشة وعدم الاستقرار السياسي، على الرغم من ذلك فهي تأتي إلى السلطة في أوضاع مختلفة؛ فحين يستلم العسكريون السلطة فإنّهم يفعلون ذلك وسط حالة من الانقسام والتصدع السياسي، وهو ما حدث في الفترات التي سبقت الانقلابات العسكرية. أما المدنيون فيأتون إلى السلطة في بيئة من التوافق النسبي على هيكل العمل السياسي وقواعده يستغل العسكريون حالة التصدع السياسي وتعاقب الحكومات الائتلافية لعكس فشل المدنيين وتبرير الانقلاب على أنه عمل وطني يرمي إلى إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتفكك يتسلّم المدنيون الحكم، في الغالب، بعد أن يعزل النظام العسكري نفسه من حلفائه المدنيين.
ويؤكد الحاج بأن أغلب الفاعلين السياسيين يصلون إلى نتيجة مفادها بأنّ النظام العسكري ليس آلية فعالة لتحقيق مصالحهم، فيتبنون ما يشبه الإجماع السياسي بينهم مفاده أن إزالة النظام العسكري أفضل الطرق لخدمة مصالحهم.
ومن خلال قراءة أحداث النزاعات العرقية في أقاليم السودان المختلفة في العقود الأخيرة، لم يكن انقلاب الرئيس السابق عمر البشير في يونيو 1989، محض قرار عسكري، إنما تدخل سياسي أيديولوجي بالتعاون مع الحركة الإسلامية، حين أخفت دوافعها عند استلامها السلطة، وأفصحت عنها بعد بضعة أشهر من انقلابها، عندما وضعت تصورها لبناء الدولة على أساس ديني، واستهدفت إحداث تغيير في التعليم والصحة والجيش وتحرير الاقتصاد وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وإقصاء غير المسلمين والموالين لفكرها في دواوين الخدمة المدنية. حيث قامت بفصل الآلاف من الموظفين وفقا لقانون أطلقت عليه "قانون الصالح العام"، كما فرضت التجنيد الإجباري، وأصدرت قانون الدفاع الشعبي، لتشكيل قوات عسكرية هي بمثابة مليشيا حزبية، تم الاعتماد عليها في محاربة التمرد في جنوب السودان، مما فاقم من أزمة الجنوب، وأجج اشتعال النزاع ومنحته بُعد أيديولوجي. وكان لأقاليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة النصيب الأوفر من الجرائم ضد الإنسانية.
نزاع دارفور
تنوع بيئي وبشري وتفرد حضاري، بعض مما يميز إقليم دارفور الذي يعتبر صورة مصغرة للسودان. هذا الإقليم المعروف بتركيبته الإثنية المعقدة، وهي خليط مجموعات أفريقية وعربية، لكنها اتسمت بالتعايش السلمي، لحرص زعماء وحكماء القبائل في الإدارة الأهلية، على تقليص الهوة بين المجموعات القبلية، بهدف ترسيخ أسس التسامح والسلام.
وحسب الدكتور محجوب محمد أدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فإن الإدارة الأهلية لعبت دوراً كبيراً في رتق النسيج الاجتماعي وإعلاء القيم الوطنية وتعضيد الاستقرار خاصة في الأماكن النائية من البلاد والتي يصعب الوصول إليها من أجهزة الدولة المعنية، لافتاً إلى أنها ظلت سنداً للأجهزة العدلية والأمنية وساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة قيم السلام بين قبائل دارفور.
وقد تعرضت دارفور خلال العقود الأخيرة إلى تفاقم ظاهرة الجفاف والتصحر، مما زاد من حالات التوتر بين السكان المحليين المعتمدين على الزراعة، والرُحل المعتمدين على الرعي. وارتفعت وتيرة الصراع، لتدفق السلاح من الداخل والخارج، لخدمة النزاع العرقي والايديولوجي الدائر في الإقليم، ساهم في ذلك العزلة الجغرافية والاجتماعية التي عاشتها دارفور منذ الاستقلال، لتجاهل الحكومات المتعاقبة للمنطقة مما يكرس الفوارق الإثنية. ارتبطت دارفور بالمناطق المتاخمة لها داخلياً كردفان وبحر الغزال، بينما ارتبطت خارجياً بدولتي تشاد وليبيا، عزز كل هذا عزلتها عن بقية أقاليم السودان، وفي ظل هذه العزلة أصبحت القبيلة هي المرجعية الأساسية.
بلغت وتيرة النزاع أشدها في العام 2003، عندما هاجمت الحركات المسلحة مناطق الحكومة السودانية، لاتهامها باضطهاد ذوي الأصول الأفريقية. وحشدت حكومة نظام البشير مجموعات إثنية مسلحة، ما يسمى مليشيات الجنجويد من ذوي الأصول العربية، لصد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتهجير ما يزيد عن مليونين، ولجوء نحو 400 ألف شخص إلى المخيمات في دولة تشاد.
لم يكن انقلاب الرئيس السابق عمر البشير في يونيو 1989، محض قرار عسكري، إنما تدخل سياسي أيديولوجي بالتعاون مع الحركة الإسلامية، حين أخفت دوافعها عند استلامها السلطة، وأفصحت عنها بعد بضعة أشهر من انقلابها
في أعقاب ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية وإبادة جماعية ضد المدنيين بدارفور.
مؤخرا أدى اندلاع القتال المفاجئ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تصاعد العنف في إقليم دارفور، وارتكبت مليشيات الدعم السريع والمليشيات العربية الأخرى أعمال قتل واسعة ضد المدنيين، وتصاعد العنف الجنسي ونهبت وأحرقت العديد من القرى والمخيمات، كما استهدفت بالقتل القادة المحليين والعاملين في منظمات دولية.
انفراط العقد
لعل السودان الدولة الأكثر تعقيدًا في أفريقيا من حيث التركيبة السكانية، وفقاً لأول تعداد سكاني تم إجراؤه قبل نصف قرن، فإن هناك أكثر من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قبيلة وعشيرة. بالرغم من أن التعدد الإثني هو قَدَر أهل السودان، وأساس النسيج الاجتماعي والثقافي السوداني، ولكن وحدة الهدف والمصير أعمق المكونات الاجتماعية؛ إلا أنها فشلت في جمع هذه المجموعات العرقية لإدارة تنوع ناجح.
ويحلل الدكتور أسامة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة التنوع بقوله: "في الواقع فالتفاوت في التنمية والفرص غير المتكافئة في تقاسم السلطة والثروة بين أقاليم السودان أشاع مشاعر قوية معادية للشماليين في بقية مناطق السودان، وقادت هذه المشاعر إلى حركات إقليمية مناهضة للدولة في دارفور وكردفان وشرق السودان بسبب المحسوبية والقبلية والإثنية فجاءت ردود أفعالهم كجزء طبيعي لفقدانهم هذا النفوذ". مما ساهم في المأزق السياسي وانقسام البلاد، وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية.
وكان يمكن للنخب الحاكمة أن تلعب دوراً فاعلاً في توحيد هذا الهدف، وصياغة مفهوم الوحدة الوطنية، وتحويله إلى مشروع سياسي؛ لكنها عمقت الخلاف حول مقومات الوحدة الوطنية، من وحدة اللغة والدين والعرق على مرور الحقب التاريخية، وتهاونت الحكومات الوطنية في جمع شتات الأقليات الإثنية، وفرطت في احترام الفوارق وتطبيق العدل والمساواة وقللت من تعزيز قيم التسامح، لتفشل بذلك الدولة السودانية، وتحصد ثمار ما زرعته من الانقسام والتشتت والحروب.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أثر الأطراف الدولية والإقليمية على هذه الوحدة منذ الاستقلال، بممارسة الضغط من خلال دعم الحركات المسلحة، لتعزيز انفراط عقد البلاد. وكان لها اليد الطولى في تفتيت السودان، وتدويل الصراع بخروجه من الإطار المحلي، ليصبح قضية رأي عالمي.
سيطرة العقل الجمعي
ارتبط الطرح الثقافي لموضوع الهوية، وصلتها بالعرق والقبلية في السودان بالعقل الجمعي للمجتمعات التي تشترك في خصائص الأرض والجغرافية والتاريخ والبيئة والتراث والفكر والوجدان. وظل معنى الهوية الإثنية والأقليات العرقية والدينية ينبثق من جذور مجتمعية وثقافة شعبية سودانية، كانت من الثوابت الراسخة عبر الحقبة التاريخية.
تجذرت هذه الثقافة طوعاً واختياراً بمرور الزمن، وأصبح الفعل الاجتماعي محكوم بالعقل الجمعي، بينما كان السلوك والتفكير تحت سطوة مؤسسات الدولة التقليدية، والتي اتجهت نحو النهج الفوقي، بالانحياز إلى العنصر العربي الإسلامي، وقد بدأ ظهور معنى الهوية أبان الممالك والسلطنات الإسلامية، حين نشأتها في القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، عقب تداخل العناصر العربية والأفريقية.
لعل السودان الدولة الأكثر تعقيدًا في أفريقيا من حيث التركيبة السكانية، وفقاً لأول تعداد سكاني تم إجراؤه قبل نصف قرن، فإن هناك أكثر من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قبيلة وعشيرة
كرست الثقافة الشعبية، تعامل مجتمع المركز والحضر مع أزمة النزاع وارتكاب جرائم تطهير عرقي في مجتمعات الهامش برد فعلى اجتماعي، تكسوه القسوة والاستبداد والعنصرية والتغافل عن الأحداث الدائرة فيها. والمرجع لهذا التعالي، هو ترسيخ الدولة لثقافة إقصاء الإثنيات العرقية في الأقاليم المهمشة، ليظل الوعي الجمعي مغيب وغير مدرك بأن النقاء العرقي وما يتصل به من تقسيم هو مجرد وهم.
الكاتب الصحافي والروائي فايز الشيخ السليك، يربط ما بين الأزمات المتتالية في السودان والعقل الجمعي في مقدمة كتابه " الزلزال .. العقل السوداني ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب " بقوله: إن المشكلة هي في (العقل الجمعي)، وإن لكل مجتمع خصائصه، وبصماته، وهي محصلة لمكونات ثقافية، وبيئية، وجينية، تجعله يُفكر، وفق إحداثيات هذه المرجعية، فوطن يتقسم، وأزمة مزمنة تحاصر ما تبقى من وطن، ومع كل ذلك يلفنا السكون، وكلما لاح وميض ضوء في آخر النفق، سرعان ما ينطفئ هذا البريق، ويختبئ هذا الوميض، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سر اضطراب دورات الحكم في بلادنا، وتقلبات الأنظمة السياسية، وركود الأحوال الاجتماعية، وفشلنا في استغلال مواردنا الطبيعية الثرة التي يزخر بها السودان، إن كل ذلك يؤكد وجود مشكلة بنيوية، مرتبطة بطبيعة تكويننا النفسي والثقافي والذهني، وانعكاسات ذلك على تصوراتنا حول الكون، والناس والأشياء، وأنفسنا والآخرين.
بروباغندا حرب السودان
ترجع جذور الصراع الدائر حاليًا بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى توظيف حكومة نظام عمر البشير السابق، لمفهوم العروبة والإسلام في استقطاب القبائل لتأييد حكمه، وإنشاء فصائل شبه عسكرية للقضاء على تمرد الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وهو ما نتج عنه حالة النزاع والتناحر العرقي في إقليم دارفور منذ العام 2003.
لم تتورع "مليشيات" الدعم السريع عن قتل المدنيين في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنار التي سيطرت عليها مؤخراً، وقامت بنهبهم واستخدمتهم كدروع بشرية، واحتجزت العديد من الأسرى، واغتصبت النساء، واستهدفت الشباب بالتجنيد القسري، وأرغمتهم على القتال
عقب تكوين هذه القوات، اعترفت الحكومة رسميا بها في العام 2013، وأصبحت قوات الدعم السريع موازية للجيش الوطني السوداني، تلاها إجازة البرلمان السوداني مشروع (قانون الدعم السريع) في يناير 2017، بإجماع نوابه على أن تتبع للجيش السوداني، بعد ما كانت تنضوي تحت لواء الأمن والمخابرات، بالرغم من أن تكوينها كان على أسس عرقية وأنها امتداد ( لمليشيات الجنجويد).
لمع محمد حمدان دقلو " حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، الذي ورث قيادة الجنجويد من قائدها موسى هلال، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019. أعقب ذلك تولي عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة، وتكليف حميدتي نائباً له. شكل البرهان وحميدتي قوة ضاربة تجاه القوى المدنية وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلنا انقلاب أطاح بالمدنيين.
لكن هذه العلاقة الوطيدة لم يقدر لها الاستمرار، فقد اتسعت الهوة بين الرجلين، بعد الإقرار بفشل الانقلاب على القوى المدنية، وتوقيع اتفاق إطاري مع المدنيين، يقضي باستعادة الانتقال المدني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. إلا أن نُذر الخلاف ظهرت على عدد سنوات الدمج، واتهام حميدتي لقائد الجيش بالعمل على عودة الإسلاميين إلى السلطة، ليصل الاختلاف إلى حافة هاوية الحرب، التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وامتدت لتعم غالبية ولايات السودان، واجتذبت أطراف أخرى، بما في ذلك الحركات المسلحة والمليشيات القبلية.
لم تتورع "مليشيات" الدعم السريع من ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاوزات بشعة بحق المدنيين في الولايات التي استولت عليها، فقد عمدت إلى قتل المدنيين في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنار التي سيطرت عليها مؤخراً، وقامت بنهبهم واستخدمتهم كدروع بشرية، واحتجزت العديد من الأسرى، واغتصبت النساء، واستهدفت الشباب بالتجنيد القسري، وأرغمتهم على القتال. كما احتلت معظم المستشفيات والمرافق الخدمية، وقامت بهدم وقصف وتدمير البنية التحتية، والمنشآت العامة، ومساكن المواطنين.
وفي دارفور ارتكبت إبادة جماعية، ضد جماعة المساليت الإثنية الأفريقية في ولاية غرب دارفور، وسيطرت على مدينة مليط وحاصرت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وهجرَّت واغتالت العديد من سكانها، ورفضت دخول المساعدات الإنسانية لهذه المدن.
إن المشهد الحالي لأزمة السودان لا يُحتمل، ومن المهم بمكان تحرك الرأي العام العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تستخدم البروباغندا والوسائل الدعائية في حرب السودان لمصالحها الضيقة، فهي تحذر وتدين وتتقصى، ولكنها فشلت في تحمل المسؤولية، بمنع وقوع المزيد من الفظائع، وتدارك الكارثة الإنسانية، وتوجيه الأنظار نحو ارتكاب جرائم وحشية وتطهير عرقي للسودانيين.
إن العالم يتجاهل السودان ويدرك حقيقة ما وراء هذه الحرب ولكنه لا يكترث لها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.