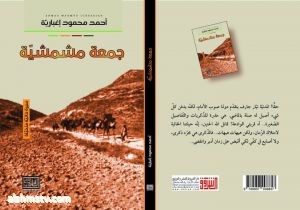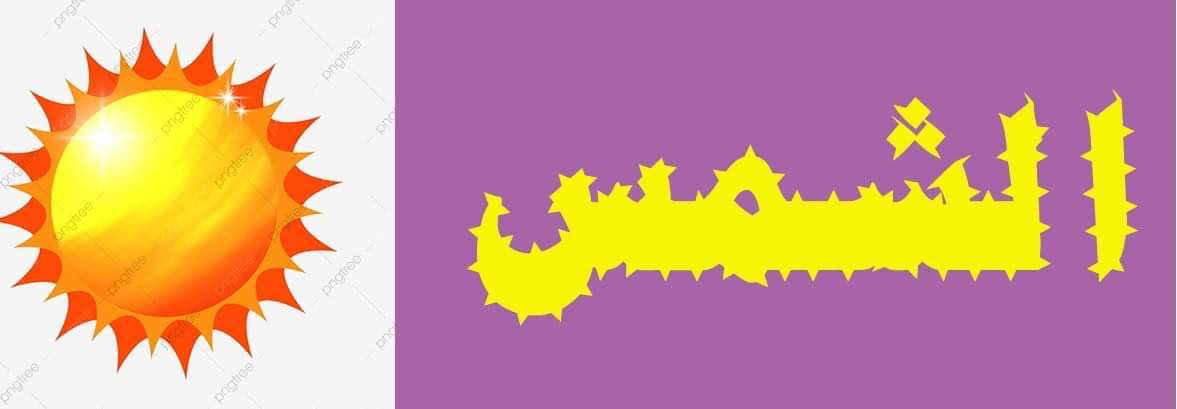Fahima Ghanayem سيزيف الفلسطينيّ والحلم المشتهى د.فهيمة غنايم

Fahima Ghanayem
سيزيف الفلسطينيّ والحلم المشتهى
د.فهيمة غنايم
إنّ الشروع بقراءة أوليّة لتجربة أدبيّة جديدة، غالبًا ما تكون بمثابة تأسيس لقراءةٍ أعمق، تكشف عن أفق جماليّاتها؛ ذلك ما عبّر عنه الفرنسيّ "باشلار" في جملته: " كلّ كتاب جيّد يجب أن تُعاد قراءته بمجرّد الانتهاء منه، فبعد القراءة الأوليّة تأتي القراءة الخلّاقة"، وقراءتي الأوليّة لرواية "جمعة مشمشيّة" لأحمد اغبارية (2023)- التي صنّفها ضمن السيرة الذاتيّة المتخيّلة، والصادرة عن دار الشروق- لم تكشف إلّا ما طفا على السطح، لأنّ سيرةً متخيّلةً كهذه لا تكفيها قراءة واحدة؛ بل تتعدّاها لسبر عمق فضاءاتها.
غير أنّ فكرة المزج بين الذاتيّ والمتخيّل في الأعمال الأدبيّة، تدفعنا للسّؤال: أين يكمن الذاتيّ؟ ومتى ينتهي المتخيّل؟ فهذا المزج كما تجلّى في رواية "جمعة مشمشية"، يخلق نصّا متشابكًا، يشكّل سمةً من سمات الأعمال التي تخلّقت ونمت، من خلال ملامح بيئةِ وشخصية الكاتب، إلى جوار فضاءات وثيمات السرد وعوالمه المتخيّلة، ورغم الإشكاليّة التي تعتري مثل هذا المزج، فإنه لا يمكن عزله عن جذوره الفلسفيّة التي تتجاوز السيرة الذاتيّة بمعناها التقليديّ كما عرّفها فيليب لوجون، بأنّ السيرة المتخيلة "حكيًا استعاديًّا نثريًّا يقوم به شخص واقعيّ لوجوده الخاص، بما يرتكز على حياته الفرديّة وعلى تاريخ شخصيّته بصفة خاصّة". فضلا عن كونها، وأقصد السيرة الذاتيّة، بشكلها التقليديّ المتعارف عليه، من البداهة أن تكون أرضاً خصبة لبعض الاعترافات التي يدخل فيها الشكّ، ولا يمكن اعتبارها حقيقة بشكل تام، فكيف الحال ونحن بصدد سيرة متخيّلة، فهو إذن مزجُ لحقيقةٍ ضاقت ذرعًا بالواقع، وتاقت لتَنَشُّقِ بعضٍ من التخييل.
*التخييل والمكان*
لم يكتفِ الكاتب في هذه السيرة بالتعامل مع أمكنته بهدف المسح الأفقيّ التوثيقيّ لبيئتها المجرّدة، وإنّما تفاعل معها بإحساس عموديّ عميق وبقيمتها الجماليّة باعتبارها بيئته الأولى، سعى أن يترك في زواياها أثرًا تأويليًّا يربط بين الزمان والمكان، كما دأب على ترديده في "جمعتة المشمشية" كتعبير عن حدثٍ لحظي، يتداعى على إثره تكثيف اللّحظة في وجه تقلّبات الزّمن التي طرأت على مدينتة أم الفحم، والتي تمثّل صورتها الأولى نموذجًا صريحًا للقرية الفلسطينيّة التي اجتاحها تيار جارف كتم أنفاسها، و"مبان مرصوصة تنتطح وتحملق إلى الناس بازدراء، فمن أين زحف كلّ هذا الحديد واستقر هنا؟! سرطان معماريّ يفتك بكلّ شيء دونما هوادة، منذ متى هذا العمران ؟!.. خليط هجين من كلّ شيء..!" ص47، قضم من ملامح تلك البقعة بساطتها وأصالتها، معيدًا ترتيب المكان بنسقٍ يوحي بسطوةٍ مخيفة، يخيّم على سمائه جشع يبدّد الفطرة، كأنّ يدًا تعبث به، "فلم تكن تلك بالمشاهد العبثيّة، بل كانت متّسقة على نحو يخيّل للمرء أنّ آلهة يونانيّة تمسك بخيوط الأحداث وتراقب من فوق جبل شاهق"ص35، فالمكان من تلك الحدقة يغزو أركان التجربة الإنسانيّة التي تخلّقت معها الذّات لدى طارق بطل هذه السيرة فأربكتها، لتتحوّل تجربته المكانيّة من صورة تكوينيّة مجرّدة إلى تجربة روحيّة تستدعي كلّ ما اكتنز في محيطها من علاقات وتبادلات تحوّل الأشياء المادية إلى تجربة حيّة تضجّ بالحياة، تستجلي وتستجلب العلاقة بين الذّات الإنسانيّة لديه ومكان نشأته في مطلع تشكّلهما، كما ورد على لسانه: "لأوّل مرة أدرك بأنّ الفضاء المكانيّ له امتدادات وأعماق تتفتّق أمام ناظريّ مسفرةً عن أبعاد جديدة" ...ص54
إنّ عناية اغبارية الدّقيقة في هذه السرديّة بتفاصيل المكان، والقدرة الفائقة على استجلاب الذاكرة الحيّة المسكونة بشجن التجربة رغم الزّمن الذي مضى على تشكّلها، استحالت إلى نوع من التأمّل بين الذّات والواقع في علاقة وجوديّة، تجلّى في قول طارق إثر عودته بعد قضائه في السجن مدة 15 عامًا بسبب تهمة ملفّقة: "إنّ البيوت الطينيّة المبعثرة على التلال من جانبيّ الطريق، ومن حولها كروم الزيتون الروميّة الممتدّة إلى ذرى الجبال وإلى ما خلف الأفق، كلّها تحقن الجسد بخدرٍ منعش.." ص40
فالمكان الذي عاد إليه طارق بعد طول غياب، ليس المكان ذاته الذي خرج منه مرغمًا منذ عقدٍ ونصف، حيث همس لنفسه قائلًا: "ها أنا أقترب من ذاتي التي تركتها منذ زمن، لا أدري إذا كان قد طال أو قصُر، ولكن هل أصدّق لهفتي المتوثّبة أم قلقي المتفاقم؟ ... كيف سأواجه المكان الذي يسمّى البلد؟ لست متأكدًا إذا كنت سأخرج منتصرًا أو مهزومًا..!" ص39
وبما أنّ الرواية بنت المكان، فإنّ العودة إليه، إنّما تشكّل استعادةً كاملةً له، بتاريخه، وأزقّته، وناسه، وطقوسه وعاداته؛ فيُستحضر ذلك المكان الذي يبوح بالحكايات، كحكاية طارق مع سلوى الحبيبة، وذكرياته مع أصدقاء الصبا، ومغامراته الشقيّة في حارات القرية وأزقّتها بعيون الكاتب وهو يردّد على لسان بطله: "عائد لكي ألتحم بذاتي التي تركتها منذ زمن بعيد، ذاتي التوّاقة للحديث عن ذاتها، .. سأراها وهي تقفز نحوي من الشقوق والحواكير والطرقات لكي تلبسني، كل ما سيقوله المكان عني هو ذاتي، .."ص46.
*العتبة النصيّة ودلالة استحضار المكان*
تشكّل العتبة النصيّة نقطة عبور تربط النصّ بعالمه الخارجيّ، حيث تكشف عن انتمائه إلى سياق أدبيّ يعكس هشاشة الزّمن في مواجهة قسوة الاحتلال، فيصبح العنوان بذلك امتدادًا رمزيًا للنصّ ومفتاحًا لفهم دلالاته، كما أشار الباحث الفلسطينيّ محمود غنايم في كتابه "غواية العنوان – النصّ والسياق في القصّة الفلسطينية"، إلى أنّ النظر إلى العنوان كوحدة مستقلّة موازية للنصّ لا ينفي العلاقة الحميمة معه، مما يجعل العنوان يقود إلى النصّ".
ويكاد البعض يجزم أنّ مقولة "جمعة مشمشية" تقتصر على السياق الفلسطينيّ، حيث تُستخدم للإشارة إلى شيءٍ مؤقتٍ وعابرٍ ضمن سياقه الزمنيّ، فتستدعي المقولة مشهد تَسابُقِ الناس في ساعات الصباح النديّة لقطف المشمش البلديّ الشهيّ، والتعلّق بأغصان الأشجار لتناول ما لذّ وطاب من مشمش بلادهم وتينها، ذلك المتهدّل على جنبات الطرقات وبين الحواكير وهم يدركون أنّ هذه اللّذة اللحظية لا تُضمن في يوم آخر.
هذا التعلّق الزمنيّ بالمشهد يبرز العلاقة الرمزيّة بين العنوان والنصّ، حيث يصبح العنوان نصًا موازيًا يعكس انتماء النصّ الأيديولوجيّ إلى سياق أدبيّ وثقافيّ وسياسيّ فلسطينيّ، مما يعزّز وظيفة العتبات النصّية في كشف خصوصيّة النصّ وتحديد مقاصده الدلاليّة الأساسيّة.
*الهُويّة بين الأصالة والمدنيّة*
لعلّ التكثيف الرمزيّ للكاتب في استحضار تفاصيل القرية التي طمرت الحداثة ملامحها، سواء بشكلها الهويّاتيّ الرمزيّ، أو الماديّ الحسّي، نابع من مركزيّةِ وهيمنةِ صورتها في المخيال الجمعيّ الفلسطينيّ، ومدى استحواذها على الوعي اللّصيق بالحنين إلى زمن مضى، وما ذلك إلّا تعبير عن بؤرةٍ وجوديّة اجتاحتها يد الغدر، واستوطنها الخوف، والفساد، والجشع، وانحسرت فيها الأصالة وتداخلت فيها الهُويّة أمام مدّ استعماريّ، حوّل الوطن إلى مستعمرة مسلوبة الرّوح، مشوّهة الملامح، مما يدفعنا إلى تأمّل تلك المسافة الزمنيّة ما بين القرويّة والمدنيّة، والأصالة والحداثة، النقاء والتلوث، الذاكرة والنسيان، الوفاء والغدر، والاستقامة المتمثلة بطارق وجبرين اللّذان يأكل الناس من لحمهما، والفساد المتمثّل بغبيشي وعرصان، وشهبندر الدبّور الذين يأكلون لحم الناس.
كان ذلك التكثيف جزءًا من مشاهد رمزيّة، تقوم بنيتها السرديّة على الاستباقيّة والاسترجاعيّة، ممّا أتاح تداخلًا زمنيًا بين الماضي والحاضر في استدعاء لتفاصيل النكبة وارتداداتها، فانعكست هذه المشاهد على ما آلت إليه الحداثة الاستعماريّة التي استهدفت طمس الهويّة الفلسطينيّة وتشويه معالمها؛ فأصبحت عمليّة الخروج الجسديّ للفلسطينيّ من جغرافيّته أكثر من مجرّد نزوح، بل فعلًا ذا دلالاتٍ عميقةٍ تدفع لاستحضار ما استقرّ في الوعي الجمعيّ من استعارات مكانيّة مركزيّة، تُجسّد ذاكرة جماعيّة مكثّفة ومهيمنة في المخيال الفلسطينيّ.
*البئر والحلم*
جاءت الرمزيّة الأسطوريّة في الأدب الفلسطينيّ من باب الالتحاق بركب الحداثة، إذ تعانقُ تلك الرمزيّة في الأسطورة رسالة مكثّفة يحاول الكاتب إيصالها للمتلقّي؛ فجاءت بئر الجامع في هذه السيرة في رمزيّةٍ مزدوجةٍ للحياة والموت، الارتواء والعطش، للموارد الطبيعية والاجتماعية، ورمز لسراديب الذات وندباتها، وقروح الفقد والخسارات، ومستودع لأحلام تبخَّرت ثم عادت لتنبض وتفيض من جديد بالماءِ المُشتَهى، الذي مِن أخلاقِه الطهر والتطهير والنقاء والرّيّ والعُذوبة، والحياة والولادة، وتجسّدَ ذلك في اعتراف طارق بأنّه "لطالما لفتت نظره البئر حتى سأل إمام الجامع عنها ... فكانت إجابته مبتورة، وكأنّما يتجنّب الخوض في هذه المسألة"، وظلّ ذلك الجانب حيًا يعاود الظهور في داخله على أنحاء شتى، حتى سمع ذات يوم من بعض المصلّين أنّ أحد الأولياء خصّ البئر بكرامة لا يدركها إلا من ينزل فيها، فصارت تستهويه عند الدخول والخروج، "ما سرّها يا ترى؟!".
تملّكت البئر طارق حتى صارت هاجسا يلازمه، إلى أن قاده فضوله ذات فجر للنظر إلى قاعها فانزلقت قدمه، فهوى واستقرّ في قعرها، غائبَ الوعي، إلى أن تهيّأ له أن سمع صوت والده فوق رأسه يقول: " طارق! إنهض. لقد تأخرت عن المدرسة"؛ بِتناول الخيال في هذا النّص يستحضر طارق لا وعيه حلمًا شاعريًّا لحظة فقدانه الوعي، فهذا الخيال الذي يُنبِّئنا عن علاقة تلك الذّات بالعالم، يدفعُنا إلى التأمّل في تلك العلاقة، فبالخيال تتوالد الصور والأحلام، والبئر في هذه السيرة المتخيّلة نجدُها مولِّدًا للصُّوَرِ والهواجس والأحلام، يفرُّ طارق إليها باحثًا عن حلمه الأثير.
ولعلّ ما جادت به الأساطير والمأثورات الشعبيّة تشي بالكثير حول آبار الماء وعيون الماء في فلسطين، لما تعنيه الماء من قداسة ارتبطت بالمعجزات، تجسّدت في انفجار عيون الماء وتدفقها بين كفيّ الأرض تنبئ بالولادة والتطهير" فطفحت البئر وغطت المياه صحن الجامع، وتفجرت العيون وغمرت أرضيّة البنك معقل الرأسماليّة، وتفجرت أخرى في عمارة شهبندر الدّبور لتجرف معها انتهازيته وعمالته، ليس هذا سوى غيض من فيض، فهنالك "عين النبيّ" و "عين الشعرة" و "وعين خالد" و "وعين جرّار" و "وعين التينة" و"وعين الذروة" وغيرها كثير، أخذت تتحدّى وتقاوم الحديد الذي نما حولها"(ص144)، فعادت تدبّ روح الحياة في المكان واجتمع الفضوليون عند مكان تدفق المياه، وتعابيرهم تعجز عن التصديق، وبعض كبار السن تجتاحهم الكثير من الذكريات الممزوجة بالحنين وقصص الحبّ التي شهدتها تلك العيون المتدفّقة بعد سنين عجاف.
*سيزيف والحلم المشتهى*
يعقد الكاتب في هذه السيرة مقاربة سيزيفيّة تتوارى خلف رؤية فلسفيّة تجسّد لا منطقيّة ولا عقلانيّة الحياة الإنسانيّة، فحين نظر بطلنا طارق إلى حوض الأسماك خلف المحقق الذي كان يحقق معه، كان لابد من استعارة مخيّلته ليقف عند أدقّ ما يمكن للقارئ أن يقف عنده، في محاولةٍ للربط بين النضال والاستمراريّة رغم تكرار الفعل، دحرًا للظلم؛ فالمرء لابد يتخيّل أنّ سيزيف يجتهد ليواصل مسيرته نحو الخلاص من ذلك الظلم الذي يثقل جسده، تمامًا كما طارق الذي جاهد كثيرًا ليعيد تدفّق المياه المسروقة إلى الخربة مؤمنٌ بحتميّة الانتصار، تمامًا كما السّمكة في الحوض، تسبح مؤمنة بالبقاء رغم عبثيّة الفعل في ظاهره، إلا أنّ الإيمان بحتميّة الوصول كفيل بملء فؤاد الإنسان بالأمل طمعًا بالتحرّر في نهاية المطاف.
وعلى الرّغم من أنّ سيزيف في أسطورته يتعرّض لعقابٍ دائم، إلّا أنّه يستمر في البحث عن خلاصه؛ وبالمثل، يكابد الشعب الفلسطيني ويظهر تصميمًا صلباً وثابتًا على الاستمرار في نضاله من أجل الحريّة، مع العلم أنّه من الصّعب عقد تشابه دقيق بين الأسطورة والنضال الفلسطيني بسبب اختلاف زمن وسياق القصتين؛ ومع ذلك، يمكن الاستدلال بالرمزيّة الأدبيّة للتعبير عن مفاهيم وجوديّة إنسانيّة تتعلق بالنضال الإنساني والصمود أمام الاحتلال والاستعمار، ويمكن استخدام هذا التصوير السرديّ لخلق حالة من الإدراك بأهميّة الاستمرار في خلق الوعي لدى الأجيال الحاضرة والقادمة وضرورة الحفاظ على الجذور التاريخيّة والإنسانيّة للمكان، والعمل المستمر والدؤوب من أجل تحقيق الحلم..... انتهى.
**قراءة في رواية "جمعة مشمشية" للكاتب الروائي أحمد اغبارية- كان من المفترض أن تُنشر هذه القراءة قبل أحداث السابع من أكتوبر، إلا أنّ الأحداث توالت وحالت دون نشرها.
أرجو لكم قراءة شيّقة.
#فهيمة_غنايم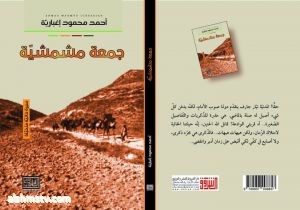
سيزيف الفلسطينيّ والحلم المشتهى
د.فهيمة غنايم
إنّ الشروع بقراءة أوليّة لتجربة أدبيّة جديدة، غالبًا ما تكون بمثابة تأسيس لقراءةٍ أعمق، تكشف عن أفق جماليّاتها؛ ذلك ما عبّر عنه الفرنسيّ "باشلار" في جملته: " كلّ كتاب جيّد يجب أن تُعاد قراءته بمجرّد الانتهاء منه، فبعد القراءة الأوليّة تأتي القراءة الخلّاقة"، وقراءتي الأوليّة لرواية "جمعة مشمشيّة" لأحمد اغبارية (2023)- التي صنّفها ضمن السيرة الذاتيّة المتخيّلة، والصادرة عن دار الشروق- لم تكشف إلّا ما طفا على السطح، لأنّ سيرةً متخيّلةً كهذه لا تكفيها قراءة واحدة؛ بل تتعدّاها لسبر عمق فضاءاتها.
غير أنّ فكرة المزج بين الذاتيّ والمتخيّل في الأعمال الأدبيّة، تدفعنا للسّؤال: أين يكمن الذاتيّ؟ ومتى ينتهي المتخيّل؟ فهذا المزج كما تجلّى في رواية "جمعة مشمشية"، يخلق نصّا متشابكًا، يشكّل سمةً من سمات الأعمال التي تخلّقت ونمت، من خلال ملامح بيئةِ وشخصية الكاتب، إلى جوار فضاءات وثيمات السرد وعوالمه المتخيّلة، ورغم الإشكاليّة التي تعتري مثل هذا المزج، فإنه لا يمكن عزله عن جذوره الفلسفيّة التي تتجاوز السيرة الذاتيّة بمعناها التقليديّ كما عرّفها فيليب لوجون، بأنّ السيرة المتخيلة "حكيًا استعاديًّا نثريًّا يقوم به شخص واقعيّ لوجوده الخاص، بما يرتكز على حياته الفرديّة وعلى تاريخ شخصيّته بصفة خاصّة". فضلا عن كونها، وأقصد السيرة الذاتيّة، بشكلها التقليديّ المتعارف عليه، من البداهة أن تكون أرضاً خصبة لبعض الاعترافات التي يدخل فيها الشكّ، ولا يمكن اعتبارها حقيقة بشكل تام، فكيف الحال ونحن بصدد سيرة متخيّلة، فهو إذن مزجُ لحقيقةٍ ضاقت ذرعًا بالواقع، وتاقت لتَنَشُّقِ بعضٍ من التخييل.
*التخييل والمكان*
لم يكتفِ الكاتب في هذه السيرة بالتعامل مع أمكنته بهدف المسح الأفقيّ التوثيقيّ لبيئتها المجرّدة، وإنّما تفاعل معها بإحساس عموديّ عميق وبقيمتها الجماليّة باعتبارها بيئته الأولى، سعى أن يترك في زواياها أثرًا تأويليًّا يربط بين الزمان والمكان، كما دأب على ترديده في "جمعتة المشمشية" كتعبير عن حدثٍ لحظي، يتداعى على إثره تكثيف اللّحظة في وجه تقلّبات الزّمن التي طرأت على مدينتة أم الفحم، والتي تمثّل صورتها الأولى نموذجًا صريحًا للقرية الفلسطينيّة التي اجتاحها تيار جارف كتم أنفاسها، و"مبان مرصوصة تنتطح وتحملق إلى الناس بازدراء، فمن أين زحف كلّ هذا الحديد واستقر هنا؟! سرطان معماريّ يفتك بكلّ شيء دونما هوادة، منذ متى هذا العمران ؟!.. خليط هجين من كلّ شيء..!" ص47، قضم من ملامح تلك البقعة بساطتها وأصالتها، معيدًا ترتيب المكان بنسقٍ يوحي بسطوةٍ مخيفة، يخيّم على سمائه جشع يبدّد الفطرة، كأنّ يدًا تعبث به، "فلم تكن تلك بالمشاهد العبثيّة، بل كانت متّسقة على نحو يخيّل للمرء أنّ آلهة يونانيّة تمسك بخيوط الأحداث وتراقب من فوق جبل شاهق"ص35، فالمكان من تلك الحدقة يغزو أركان التجربة الإنسانيّة التي تخلّقت معها الذّات لدى طارق بطل هذه السيرة فأربكتها، لتتحوّل تجربته المكانيّة من صورة تكوينيّة مجرّدة إلى تجربة روحيّة تستدعي كلّ ما اكتنز في محيطها من علاقات وتبادلات تحوّل الأشياء المادية إلى تجربة حيّة تضجّ بالحياة، تستجلي وتستجلب العلاقة بين الذّات الإنسانيّة لديه ومكان نشأته في مطلع تشكّلهما، كما ورد على لسانه: "لأوّل مرة أدرك بأنّ الفضاء المكانيّ له امتدادات وأعماق تتفتّق أمام ناظريّ مسفرةً عن أبعاد جديدة" ...ص54
إنّ عناية اغبارية الدّقيقة في هذه السرديّة بتفاصيل المكان، والقدرة الفائقة على استجلاب الذاكرة الحيّة المسكونة بشجن التجربة رغم الزّمن الذي مضى على تشكّلها، استحالت إلى نوع من التأمّل بين الذّات والواقع في علاقة وجوديّة، تجلّى في قول طارق إثر عودته بعد قضائه في السجن مدة 15 عامًا بسبب تهمة ملفّقة: "إنّ البيوت الطينيّة المبعثرة على التلال من جانبيّ الطريق، ومن حولها كروم الزيتون الروميّة الممتدّة إلى ذرى الجبال وإلى ما خلف الأفق، كلّها تحقن الجسد بخدرٍ منعش.." ص40
فالمكان الذي عاد إليه طارق بعد طول غياب، ليس المكان ذاته الذي خرج منه مرغمًا منذ عقدٍ ونصف، حيث همس لنفسه قائلًا: "ها أنا أقترب من ذاتي التي تركتها منذ زمن، لا أدري إذا كان قد طال أو قصُر، ولكن هل أصدّق لهفتي المتوثّبة أم قلقي المتفاقم؟ ... كيف سأواجه المكان الذي يسمّى البلد؟ لست متأكدًا إذا كنت سأخرج منتصرًا أو مهزومًا..!" ص39
وبما أنّ الرواية بنت المكان، فإنّ العودة إليه، إنّما تشكّل استعادةً كاملةً له، بتاريخه، وأزقّته، وناسه، وطقوسه وعاداته؛ فيُستحضر ذلك المكان الذي يبوح بالحكايات، كحكاية طارق مع سلوى الحبيبة، وذكرياته مع أصدقاء الصبا، ومغامراته الشقيّة في حارات القرية وأزقّتها بعيون الكاتب وهو يردّد على لسان بطله: "عائد لكي ألتحم بذاتي التي تركتها منذ زمن بعيد، ذاتي التوّاقة للحديث عن ذاتها، .. سأراها وهي تقفز نحوي من الشقوق والحواكير والطرقات لكي تلبسني، كل ما سيقوله المكان عني هو ذاتي، .."ص46.
*العتبة النصيّة ودلالة استحضار المكان*
تشكّل العتبة النصيّة نقطة عبور تربط النصّ بعالمه الخارجيّ، حيث تكشف عن انتمائه إلى سياق أدبيّ يعكس هشاشة الزّمن في مواجهة قسوة الاحتلال، فيصبح العنوان بذلك امتدادًا رمزيًا للنصّ ومفتاحًا لفهم دلالاته، كما أشار الباحث الفلسطينيّ محمود غنايم في كتابه "غواية العنوان – النصّ والسياق في القصّة الفلسطينية"، إلى أنّ النظر إلى العنوان كوحدة مستقلّة موازية للنصّ لا ينفي العلاقة الحميمة معه، مما يجعل العنوان يقود إلى النصّ".
ويكاد البعض يجزم أنّ مقولة "جمعة مشمشية" تقتصر على السياق الفلسطينيّ، حيث تُستخدم للإشارة إلى شيءٍ مؤقتٍ وعابرٍ ضمن سياقه الزمنيّ، فتستدعي المقولة مشهد تَسابُقِ الناس في ساعات الصباح النديّة لقطف المشمش البلديّ الشهيّ، والتعلّق بأغصان الأشجار لتناول ما لذّ وطاب من مشمش بلادهم وتينها، ذلك المتهدّل على جنبات الطرقات وبين الحواكير وهم يدركون أنّ هذه اللّذة اللحظية لا تُضمن في يوم آخر.
هذا التعلّق الزمنيّ بالمشهد يبرز العلاقة الرمزيّة بين العنوان والنصّ، حيث يصبح العنوان نصًا موازيًا يعكس انتماء النصّ الأيديولوجيّ إلى سياق أدبيّ وثقافيّ وسياسيّ فلسطينيّ، مما يعزّز وظيفة العتبات النصّية في كشف خصوصيّة النصّ وتحديد مقاصده الدلاليّة الأساسيّة.
*الهُويّة بين الأصالة والمدنيّة*
لعلّ التكثيف الرمزيّ للكاتب في استحضار تفاصيل القرية التي طمرت الحداثة ملامحها، سواء بشكلها الهويّاتيّ الرمزيّ، أو الماديّ الحسّي، نابع من مركزيّةِ وهيمنةِ صورتها في المخيال الجمعيّ الفلسطينيّ، ومدى استحواذها على الوعي اللّصيق بالحنين إلى زمن مضى، وما ذلك إلّا تعبير عن بؤرةٍ وجوديّة اجتاحتها يد الغدر، واستوطنها الخوف، والفساد، والجشع، وانحسرت فيها الأصالة وتداخلت فيها الهُويّة أمام مدّ استعماريّ، حوّل الوطن إلى مستعمرة مسلوبة الرّوح، مشوّهة الملامح، مما يدفعنا إلى تأمّل تلك المسافة الزمنيّة ما بين القرويّة والمدنيّة، والأصالة والحداثة، النقاء والتلوث، الذاكرة والنسيان، الوفاء والغدر، والاستقامة المتمثلة بطارق وجبرين اللّذان يأكل الناس من لحمهما، والفساد المتمثّل بغبيشي وعرصان، وشهبندر الدبّور الذين يأكلون لحم الناس.
كان ذلك التكثيف جزءًا من مشاهد رمزيّة، تقوم بنيتها السرديّة على الاستباقيّة والاسترجاعيّة، ممّا أتاح تداخلًا زمنيًا بين الماضي والحاضر في استدعاء لتفاصيل النكبة وارتداداتها، فانعكست هذه المشاهد على ما آلت إليه الحداثة الاستعماريّة التي استهدفت طمس الهويّة الفلسطينيّة وتشويه معالمها؛ فأصبحت عمليّة الخروج الجسديّ للفلسطينيّ من جغرافيّته أكثر من مجرّد نزوح، بل فعلًا ذا دلالاتٍ عميقةٍ تدفع لاستحضار ما استقرّ في الوعي الجمعيّ من استعارات مكانيّة مركزيّة، تُجسّد ذاكرة جماعيّة مكثّفة ومهيمنة في المخيال الفلسطينيّ.
*البئر والحلم*
جاءت الرمزيّة الأسطوريّة في الأدب الفلسطينيّ من باب الالتحاق بركب الحداثة، إذ تعانقُ تلك الرمزيّة في الأسطورة رسالة مكثّفة يحاول الكاتب إيصالها للمتلقّي؛ فجاءت بئر الجامع في هذه السيرة في رمزيّةٍ مزدوجةٍ للحياة والموت، الارتواء والعطش، للموارد الطبيعية والاجتماعية، ورمز لسراديب الذات وندباتها، وقروح الفقد والخسارات، ومستودع لأحلام تبخَّرت ثم عادت لتنبض وتفيض من جديد بالماءِ المُشتَهى، الذي مِن أخلاقِه الطهر والتطهير والنقاء والرّيّ والعُذوبة، والحياة والولادة، وتجسّدَ ذلك في اعتراف طارق بأنّه "لطالما لفتت نظره البئر حتى سأل إمام الجامع عنها ... فكانت إجابته مبتورة، وكأنّما يتجنّب الخوض في هذه المسألة"، وظلّ ذلك الجانب حيًا يعاود الظهور في داخله على أنحاء شتى، حتى سمع ذات يوم من بعض المصلّين أنّ أحد الأولياء خصّ البئر بكرامة لا يدركها إلا من ينزل فيها، فصارت تستهويه عند الدخول والخروج، "ما سرّها يا ترى؟!".
تملّكت البئر طارق حتى صارت هاجسا يلازمه، إلى أن قاده فضوله ذات فجر للنظر إلى قاعها فانزلقت قدمه، فهوى واستقرّ في قعرها، غائبَ الوعي، إلى أن تهيّأ له أن سمع صوت والده فوق رأسه يقول: " طارق! إنهض. لقد تأخرت عن المدرسة"؛ بِتناول الخيال في هذا النّص يستحضر طارق لا وعيه حلمًا شاعريًّا لحظة فقدانه الوعي، فهذا الخيال الذي يُنبِّئنا عن علاقة تلك الذّات بالعالم، يدفعُنا إلى التأمّل في تلك العلاقة، فبالخيال تتوالد الصور والأحلام، والبئر في هذه السيرة المتخيّلة نجدُها مولِّدًا للصُّوَرِ والهواجس والأحلام، يفرُّ طارق إليها باحثًا عن حلمه الأثير.
ولعلّ ما جادت به الأساطير والمأثورات الشعبيّة تشي بالكثير حول آبار الماء وعيون الماء في فلسطين، لما تعنيه الماء من قداسة ارتبطت بالمعجزات، تجسّدت في انفجار عيون الماء وتدفقها بين كفيّ الأرض تنبئ بالولادة والتطهير" فطفحت البئر وغطت المياه صحن الجامع، وتفجرت العيون وغمرت أرضيّة البنك معقل الرأسماليّة، وتفجرت أخرى في عمارة شهبندر الدّبور لتجرف معها انتهازيته وعمالته، ليس هذا سوى غيض من فيض، فهنالك "عين النبيّ" و "عين الشعرة" و "وعين خالد" و "وعين جرّار" و "وعين التينة" و"وعين الذروة" وغيرها كثير، أخذت تتحدّى وتقاوم الحديد الذي نما حولها"(ص144)، فعادت تدبّ روح الحياة في المكان واجتمع الفضوليون عند مكان تدفق المياه، وتعابيرهم تعجز عن التصديق، وبعض كبار السن تجتاحهم الكثير من الذكريات الممزوجة بالحنين وقصص الحبّ التي شهدتها تلك العيون المتدفّقة بعد سنين عجاف.
*سيزيف والحلم المشتهى*
يعقد الكاتب في هذه السيرة مقاربة سيزيفيّة تتوارى خلف رؤية فلسفيّة تجسّد لا منطقيّة ولا عقلانيّة الحياة الإنسانيّة، فحين نظر بطلنا طارق إلى حوض الأسماك خلف المحقق الذي كان يحقق معه، كان لابد من استعارة مخيّلته ليقف عند أدقّ ما يمكن للقارئ أن يقف عنده، في محاولةٍ للربط بين النضال والاستمراريّة رغم تكرار الفعل، دحرًا للظلم؛ فالمرء لابد يتخيّل أنّ سيزيف يجتهد ليواصل مسيرته نحو الخلاص من ذلك الظلم الذي يثقل جسده، تمامًا كما طارق الذي جاهد كثيرًا ليعيد تدفّق المياه المسروقة إلى الخربة مؤمنٌ بحتميّة الانتصار، تمامًا كما السّمكة في الحوض، تسبح مؤمنة بالبقاء رغم عبثيّة الفعل في ظاهره، إلا أنّ الإيمان بحتميّة الوصول كفيل بملء فؤاد الإنسان بالأمل طمعًا بالتحرّر في نهاية المطاف.
وعلى الرّغم من أنّ سيزيف في أسطورته يتعرّض لعقابٍ دائم، إلّا أنّه يستمر في البحث عن خلاصه؛ وبالمثل، يكابد الشعب الفلسطيني ويظهر تصميمًا صلباً وثابتًا على الاستمرار في نضاله من أجل الحريّة، مع العلم أنّه من الصّعب عقد تشابه دقيق بين الأسطورة والنضال الفلسطيني بسبب اختلاف زمن وسياق القصتين؛ ومع ذلك، يمكن الاستدلال بالرمزيّة الأدبيّة للتعبير عن مفاهيم وجوديّة إنسانيّة تتعلق بالنضال الإنساني والصمود أمام الاحتلال والاستعمار، ويمكن استخدام هذا التصوير السرديّ لخلق حالة من الإدراك بأهميّة الاستمرار في خلق الوعي لدى الأجيال الحاضرة والقادمة وضرورة الحفاظ على الجذور التاريخيّة والإنسانيّة للمكان، والعمل المستمر والدؤوب من أجل تحقيق الحلم..... انتهى.
**قراءة في رواية "جمعة مشمشية" للكاتب الروائي أحمد اغبارية- كان من المفترض أن تُنشر هذه القراءة قبل أحداث السابع من أكتوبر، إلا أنّ الأحداث توالت وحالت دون نشرها.
أرجو لكم قراءة شيّقة.
#فهيمة_غنايم