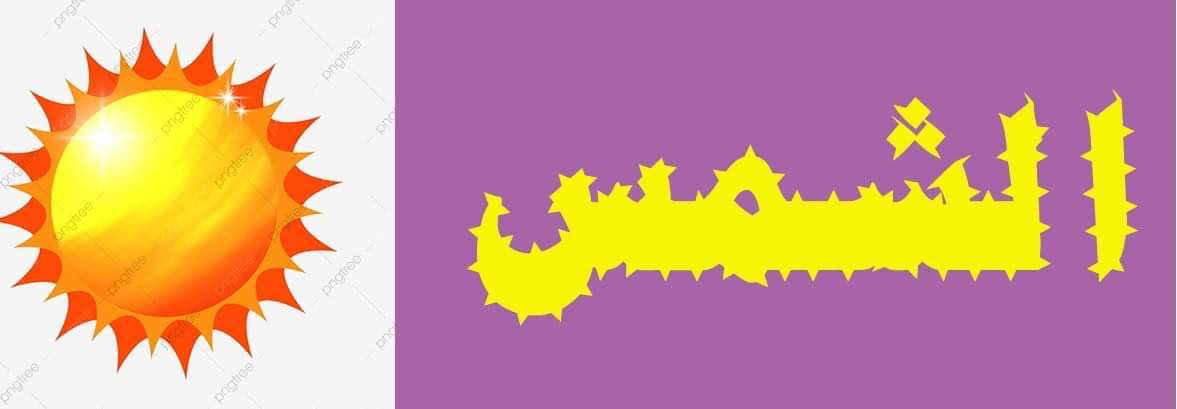مقبرة الأحياء للروائية اللبنانية الفرنسية لونا قصير
فراشة الرواية / لونا قصير
جميع الحدائق تتشابه، لكن حديقة أم جميلة” كانت مختلفة ، لم يكن فيها سحر ألوان جميع الفصول، لقد توحدت جميعها في فصل واحد حزين سميتّه الشيخوخة. وجوه غاب عنها بريق الحياة، وأجساد كهلة حملت على أكتافها سنوات طويلة مضت في آخرحقبة من عمر لم يبق منه الكثير. اجتمعوا معاً، ونسوا قصصهم القديمة بعد أن ماتت من عصور ليحتل مكانها، هاجس”ما قبل الوداع الأخير”.
اليوم قررت زيارة أم جميلة، بالرغم من أنني سمعت أهل القرية يؤكدون بأن ذاكرتها ضعفت، ولم تعد تعرف حتى أقرب الناس إليها..
لم أقتنع بكلامهم ورحت أتساءل :
– لا.. مستحيل أن تنساني، لا بدّ أن تتذكرني..
عندما وصلت إلى المأوى، لم تكن الساعة قد تجاوزت الرابعة مساء، وقفت أمام باب كبير، وطرقت بقوة عليه، دقائق، سمعت خطى ثقيلة تزداد قوتها عند اقترابها من الباب الخارجي، وإذ بسيدة في العقد السادس من عمرها، تفتح لي الباب.. شعرها أسود قصير، تضع على عينيها نظارات كبيرة، نظرت إليّ وسألتني:
– مساء النور، هل من أقرباء لك هنا ؟
جاوبتها بعفوية:
– أم جميلة.. أنا صديقتها، جئت لزيارتها..
تفاجأت قائلة لي:
– لكن الزيارات تجوز فقط للعائلة..
انتابني قلق، وبدأ العرق يتصبب من وجهي، فجاوبتها بعصبية وقلت لها:
– لكنني صديقتها، وهي تعرفني جيدًا..
ابتسمت ابتسامة اصطناعية وقالت لي:
– تفضلي…
شعرت بانزعاج شديد، وكأنني دخيلة لا يحق لي أن أتواجد في هذا المكان.. لم أيأس وتحملت أسئلتها. أيقنت من كلامها بأنه لا أحد يزور أم جميلة..
دخلت ورحت أبحث عنها من بين وجوه عديدة جميعها تتشابه من بعيد، تجاعيد عميقة تاركة آثارًا أفسدتها السنون، وعيون زائغة تنظر إليّ، وتتساءل من هذه الغريبة في ديارنا؟
لم أهتم كثيرًا لنظراتهم، ورحت أفتش عن صاحبة الشعر الأبيض كنفناف الثلج، متأكدة بأنني سأعرفها من أول نظرة، لكن كنت خائفة، هل هي ستعرفني؟
لم يمض بضع دقائق، وجدتها في زاوية القاعة الكبيرة، قابعة في كرسيها وحيدة تتأمل الفراغ.. سرّعت خطواتي، وما إن اقتربت قليلاً، بدأت ابتسامتها تتسع أكثر إلى أن وصلت بقربها، فضحكت بصوت عال، وعيناها برقتا من الفرح.
هل عرفتني أم جميلة ؟ هل حقاً استطاعت أن تميز وجهي عن بعد عدة أمتار، أم أنها مجرد صدفة؟
انحنيت لأقبلها، وإذ بها تضمني بقوة، وتشمني كما تشم الأم أطفالها، وتمرر أصابعها على شعري بلطف، تبكي وتضحك في الوقت نفسه. تأثرت جدًا لكنني تمالكت نفسي عن البكاء أمامها. سعادتي كانت لا توصف، لقد استطعت أن أزرع البهجة في قلب، غلبه الدهر، وإن لفترة قصيرة. انتهى وقت العناق والأشواق، جلست بالقرب منها، لكنها أبت أن تترك يدي، كانت تتمسك بها خائفة، وكأنها تريدني أن أبقى بقربها..
سألتها:
– كيف حالك يا أم جميلة؟
ابتسمت من جديد، وراحت تسألني عن أولادي الثلاثة بأسمائهم.. أصبت بالدهشة! من قال إن ذاكرتها ضعيفة؟ شردت قليلاً.. ومن ثم ضحكت ضحكة غريبة، وراحت تشير بيديها إلى من حولها قائلة:
– لا داعي لأن أفسر لك .. انظري إليهم وستفهمين قصصهم.
وإذ بممرضة تقترب ناحيتنا، وفي عينيها أسئلة عديدة. ما إن أصبحت بجانبنا، حتى شدّت أم جميلة على يدي بقوة وغمرتني، نظرت الممرضة إليّ متعجبة وقالت لي:
– كيف تعرفت أم جميلة إليك ؟ فهي لا تتكلم مع أحد، وتجلس معظم الأحيان وحيدة.. كما أنها تتعبنا كثيرًا في فترة الغذاء، ولا تأكل.. هي عنيدة، ليتك تستطيعين أن تساعدينا في اطعامها اليوم؟
أم جميلة تحدق بها، لكن ضحكتها اختفت..
استمتعت مع أم جميلة في فترة الغذاء ، ولم تعذبني قط ، وبعد انتهاء وجبة الغذاء، عدنا إلى مكاننا. ما هي إلا ثوان، حتى غفت على الكرسي في نوم عميق، لكنها لم تترك يدي، ولم أتجرأ أن أتحرك من مكاني.. رحت أتأمل زملاءها في الصالة، شعرت وكأنني أشاهد فيلماً، أبطاله يشبهون بعضهم البعض في الشكل فقط.. بهدوء سحبت يدي من يدها، ورحت أتجول بين زملائها، أحاول أن أحزر قصة كل واحد منهم، وما الذي أتى بهم إلى هذا المكان، وهم لم يملوا من ملاحقتي بنظراتهم..
فجأة توقفت أمام سيدة جالسة على كرسيّ متحرك، لكنها جامدة كالصنم لا تتحرك: يا إلهي.. ثريا ! ماذا تفعل هنا؟
مسكينة ثريا، كانت جارتنا في طرابلس، أصيبت بشلل نصفي منذ سنوات عديدة، حتى إني أذكر أن لغتها العربية ضعيفة.. اقتربت منها وحاولت أن أسألها عن حالها، لكنها لم تبتسم ولم تتكلم معي بالرغم من أنني كررت عدة مرات السؤال..
وإذ بسيدة نحيلة جدًأ تمر بالقرب مني، خطوات قليلة وتعود، لا تمّل من التنزه ذهاباً وإياباً، ولم تشح نظرها عني، ترمقني بنظرات غريبة، رأسها مرفوع، وتمسك بتنورتها كي لا تقع منها، وتحدق بي بتشاوف. اقتربت منها، وكما توقعت، تنورتها من غير سحاب.. نظرت إليّ نظرة استكبار وقالت لي : بأنها بنت الحسب والنسب، وينادونها الست سعاد..
وتابعت نزهتها، كأنها تدور حول نفسها في صالة ملتّ من خطواتها، وهي لم تمل منها..
فجأة سمعت سيدة تصرخ بصوت عال قائلة: أنتِ ..أنتِ، تعالي تعالي إلى هنا.. التفت ناحيتها، راحت تشير بيديها لأقترب منها، دنوت منها، وهي لا تزال تردد كلمة” تعالي”.. وجدتها مقيّدة من خصرها إلى كرسيها بحبل أبيض اللون، انتابني غضب شديد…
اقتربت منها، وإذ بها تتمسك بطرف فستاني وتشدني إليها بقوة، خوفا من أن أبتعد عنها.. سألتها عن اسمها راحت تصرخ بصوت عال وهي تبتسم : عليا.. عليا..
وتكمل قائلة :
– إن فككت قيدي سنذهب معاً إلى الضيعة، وأعطيك زيتاً وصابوناً.. ستقضين النهار معي ومع أولادي، إنهم ينتظرونني..
سألت الممرضة: كيف يمكن أن تقيّدوا امرأة عجوزاً في هذا الشكل ؟ لم تهتم لانفعالي وجاوبتني بكل برودة أعصاب، بأنها لا تستطيع أن لا نقيدها، فهي ليست واعية، ويمكن أن تخلع ثيابها في أي لحظة، وتقضي حاجتها أمام الجميع..
هنا تدخلت عليا وبدا الغضب والخوف عليها، نظرت إلى الممرضة بعصبية وقالت لها : أنتِ اسكتي..
ومن ثم راحت توجه كلامها لي، وتضحك بصوت عال لكي تعيد الطمأنينة إليّ، علني اقتنع بدعوتها للذهاب معها إلى قريتها، من أجل الزيت والصابون.. كم شعرت بالأسى، والحزن ؟، كيف لي أن أساعد عليا ؟ وقفت مذهولة أمامها، لا أستطيع أن أساعدها، فهنا القوانين صارمة، ولست إلا عابرة سبيل ، تمنيت الموت إن كنت في يوم من الأيام سأكون في وضع مشابه لها، لم أجد إلا اسماً واحدًا له: مقبرة الأحياء.
طرفت بنظري لأطمئن على أم جميلة، رأيتها لا تزال تغط في نوم عميق، رحت أتساءل هل حقاً مكانها بينهم؟ فهي لا تشكو من شيء بالمقارنة بهم. وإذ بي ألمح رجلاً متجهم الوجه في العقد السابع من عمره، يجلس أمام طاولة صغيرة، وأمامه ورقة بيضاء وقلم، لا يتكلم، يرتدي طقماً قديماً، نخره العثّ، ممزقاً قليلاً ناحية الأكتاف، والأكمام .. حاولت أن أكلمه لكنه لم يجبني..
لم أسال الممرضة هذه المرة، هي التي اقتربت مني وقالت لي :
– هذا علي .. إنه يحب الشعر والأدب ، يريد أن يكتب قصيدة منذ قدومه إلى الدار، لكنه حتى يومنا هذا لم يكتب بعد كلمة ..
فجأة نطق علي، ونظر إليّ قائلاً:
– يا ابنتي.. يسألون عني في المواسم، أخاف أن تمر الفصول، ويمحي اسمي مع أول سقوط لحبات مطر، على طرقات النسيان، وأبقى وحيدًا مع ذاكرة مهترئة لقد أضعت بوصلتي.، أكتب على أوراق وأكتب، وتبقى بيضاء، لن يفهمها إلا من عرفني يوماً ولن يقرأها أحبائي. لمن أكتب؟ لم يعد لديهم أي شيء عندي. ضاعت ذاكرتي؟ أقربهم أبعدهم وأبعدهم في قلبي . كيف نسيت تفاصيل سنيّ حياتي؟ ليتني كتبتها لأعرف من أنا ؟ أعلم أن الوقت قصير لأعود وأتذكر..
ومن ثم ناولني الورقة البيضاء، وراح يتأمل سقف الصالة من غير أن يرف بعينيه. أخذتها منه بلطف، ووضعتها بتأنٍ في جيبي، فبالرغم من أنها مجرد ورقة بيضاء، لكنها تحمل معاني كثيرة بالنسبة لي، لأنه أخبرني بما لم يرد أن يكتب عليها..
في الطرف الاَخر من الصالة، مجموعة من السيدات، يشاهدن التلفاز، واحدة منهن راحت تتكلم بصوت عال، وتضحك. انزعجت منها زميلتها، فهي لم تعد تستطيع أن تتابع برنامجها المفضل ، بدأت تصرخ عليها وتأمرها بالسكوت ، عمت الفوضى بينهن وبدأن يتفوهن بكلمات نابية فيما بينهن، كل واحدة تتّهم الأخرى.. تدخلت الممرضة، لتعقد هدنة بينهن، لكنها لم تدم طويلاً…
أخيرًا استفاقت أم جميلة، دنوت منها، نظرت إليّ، بدت متعبة، وتزايلت ضحكتها، ربما شعرت أن وقت الرحيل قد حان، وستعود لتجد نفسها وحيدة.
اقتربت منها وقلت لها يجب أن أذهب، لكنني وعدتها أنني سوف أعود مراراً لزيارتها. هزت برأسها وراحت تحدق إلى الأرض..
وقبل أن أخرج من الباب التّفت نحوها، لألقي نظرة عليها، رأيتها تلاحق خطواتي إلى لحظة ابتعادي عن نظرها، وعادت لتغوص في حزنها ووحدتها..
زرت أم جميلة عدة مرات ولعبنا معاً، كما أخذتها إلى خارج المأوى، وتجوّلنا في السيارة، ورافقتها إلى بيتها القديم علني أستطيع أن أدخل البهجة إلى قلبها، وفي كل مرة عندما يحين موعد العودة إلى الدار، لم تكن تتأفف، بل كالشاة الصغيرة، تسمع كلامي وتهز رأسها، أوصلها وأقول لها : إلى اللقاء. فتبتسم.
رب لقاء أو رب فراق في الموعد الاَتي، من يعلم؟
كان الصيف على الأبواب، استيقظت ليلتئذ قلقة، أعرف أن الأحلام لا تغشني أبداً، وفي اليوم التالي، عندما ذهبت لزيارتها، كنت قد وصلت متأخرة، لقد تحقق ما رأيته في الحلم..
ماتت أم جميلة.. أيقنت حينها أن الموت لا شيء، الأصعب ما قبله.
الموت حقّ علينا.. نقول إنه بعيد، لكنه مهما كان بعيداً هو أقرب ممّا نعتقد.
نحاول كلّ يوم أن نبتعد عن التفكير فيه، وذلك بالالتفات إلى حياتنا اليومية. فكيف إن وقف أمامنا يهددننا كل يوم، وكلّ ساعة ؟
رحلت الجارة والمربية سنوات مديدة، رحلت من شاركتني في الكثير من مشاكلي يوم كنت مراهقة وعروساً، كانت المربية والأم والصديقة، تعيش مع العائلة منذ ضفائر صباها، اهتمت بي ، وعاملتني كابنة لها، كنت طفلتها الثانية المدللة.
“أم جميلة” تزوجت في سن الأربعين من عمرها، وكان لها من زواجها بنت وحيدة. ماتت المسكينة مرتين. المرة الأولى يوم دقّ المرض بابها دون استئذان، وأصاب فلذة كبدها الوحيدة مرض عضال فتك بها في عزّ شبابها والمرة الثانية عندما استسلمت ابنتها له.
لا أدري كم مات من زملائها ؟ لا تزال صورهم في مخيلتي، وبالرغم من حزني أبتسم في بعض الأحيان عندما أتذكرهم، لقد رأيت في وجوههم وكلامهم الطيبة والبراءة، رأيت في عيونهم حزناً عميقا؛ فبالرغم من قصصهم المختلفة إلا أنهم جميعاً، توحدوا في قصة واحدة، بعد أن أصبحوا ثقلاً على أولادهم وأقربائهم وأحبائهم..
انتهى الصيف، حان موعد السفر من جديد، بالرغم من حزني الشديد على فراقها، شعرت بالراحة لأنني استطعت أن أدخل ولو القليل من البهجة إلى قلبها، قبل رحيلها عن هذه الدنيا، كما أنني تمنيت يومذاك، إن كان لابد لي من هذه الكأس، فلتكن مترافقة مع شيء من الرحمة. إن الرحمة كما تجوز على الأموات في قبورهم تجوز أيضاً على الطيّبين في حياتهم..