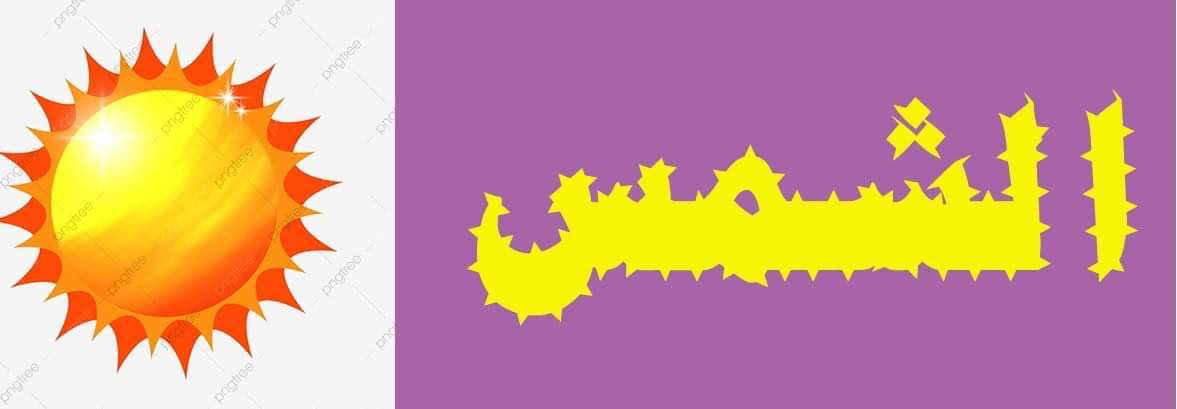حين تسقط ورقة التوت عن أوهامنا.. بقلم: ريتا الحكيم -سورية

حين تسقط ورقة التوت عن أوهامنا
الدخان كثيف، روائح التبغ والمشروبات الكحولية، وموسيقا الجاز تملأ الأجواء في البار الذي يقصده كل مساء سكان الحي المجاور، والذي يفيض الفقر عن حاجة قاطنيه، لكنهم لا يتوانون عن طقوسهم مهما جاعت بطونهم، يجدون في الخمر الرديء الذي يقدمه لهم يعقوب، ملاذًا آمنا، وهروبًا من أرقٍ سيُلقي القبض على غفوتهم فيما لو لم يأتوا إليه، مُحمَّلين بكوابيس ليلتهم السابقة حين يتعذَّر عليهم المجيء بسبب شحِّ النقود في جيوبهم.
يعقوب لا يشرب الخمر لكنه يبيعه لهم، يشترون منه لحظات اللذةِ، والشَّبق وهم يراقبون فتيات الليل ينادمن زبائنهن.
في الزوايا المعتمة من البار تتشابك الأيدي وتكثر الهمهمات والوشوشات.. ثم فجأة تعلو الضحكات الهستيرية، معلنةً عن بدء طقوس الثمالة في محاولاتٍ يائسةٍ لخلع أثواب ذواكرَ مثقلةٍ بالعفن، وممتلئةٍ بثقوبٍ لم ينجح النسيان في رتقها.
كنت من روَّاد البار الدائمين، أتأبَّط خيبة أيامي الماضية وأعاقرها خمرة يعقوب الرديئة، ثم أجلسها على حضني وأداعبها كطفلةٍ صغيرةٍ لم أفلح في إنجابها يومًا.
تصدح الموسيقا في الأجواء، وتبدأ القدود المياسة بالرقص والعناق الحار على أنغام أغاني الستينيات التي كان يعقوب شغوفًا بها، وهذه هي الميزة الوحيدة التي جعلتني لا أنقطع عن البار رغم كل سيئاته.
هنا في هذا الجو الخانق أستعيد بعضًا منِّي بعد عدة كؤوس، وتبدأ رحلة العودة إلى الوراء، إلى "شام" الممشوقة القوام، ونهديها العارمين حين يعانقان زرقة السماء، كيف يجتمع رخام صدرها وقبة السماء؟
لطالما سألتها عن السر في ذلك، كانت تجيبني بقبلة وعناق.. تضع سبابتها على شفتيَّ لتزيد من شهوتي وأنا أطوِّق خصرها الذي يشبه مدنًا بكرًا لم تطأها أقدام الحرب، تُلقي برأسها الجميل على كتفي وجسدها البض يلتصق بجسدي لنشكل بذلك لُحمةً وطنيَّةً لا تمتُّ بصلةٍ لتلك اللحمة التي يتداولونها في النشرات الإخبارية والصحف المحلية.
"شام" تذوب بين ذراعي وأغنية إديث بياف La foule
تطوينا تحت جناحيها، هربًا من كلِّ الشِّعارات التي أتخموا بها عقولنا القاصرة.. الجسد هو الوطن الأمُّ، منه اشتقَّتِ الحياة اسمها وعنوان سكنها.
يبدأ الآن دور يعقوب في الشتم وكيل اللعنات على السكارى.. أصحو من رحلتي إلى الماضي وأربِّت على كتف يعقوب في محاولة مني لتهدئته، وإقناعه بأنه يتصرف مثل رجال السُّلطة مع الشعب، حين يقطع أعناق أحلامهم.. أو يئدها حيَّةً.. أو تحت التعذيب في أقبية الموت.
لم أتمالك نفسي وقلت له:
- دعهم في أحلامهم الوردية، ولا تمارس القمع معهم.. يكفيهم قمع رجالات الوطن.
يطأطئ يعقوب رأسه ويعود أدراجه إلى مكانه المعتاد بين زجاجات الخمر والكؤوس، ولا يغادرني إلا وهو يكرر سؤاله اللجوج:
- ألم تسأم من أحلامك؟، وترتفع ضحكته لتقطع صمت الجدران الحزين.
طلبت زجاجة أخرى لأكمل درب نزوحي إلى رحم الذكريات، وأطفئ حرائق مدينتي بأعقاب سجائري وكأنني أنتقم لها ولنفسي و"لشام".
"شام" ناشطة سياسية تدعم الأحرار وتدافع عن المعتقلين.. إنها فاكهة الجنة على الأرض، دخلت السجن مرَّاتٍ ومرَّات، ولم تتحدث معي عن معاناتها بين القضبان.. ولأنني أحترم صمتها، لم أسألها عن أي شيء.. تركت لها الأمر وأنا على يقين أنها ستفضي لي وتبوح بأدق التفاصيل حول تلك المرحلة التي تشاركناها، حين كانت داخل السجن.. وأنا كنت خارجه.
كيف لهذا القلب النابض بالحب والفكر النيِّر أن يُزجَّ به في أقبية التعذيب؟
كيف لهذا الحماس أن يدفن في رطوبة القهر؟
هذه الأسئلة ما فتئت تنخر تفكيري، إلى أن أُفرجَ عن "شام" ولم أصدق ذلك إلا حين رأيتها بكامل عنفوانها، وحزنها البهي تعانقتي؛ لتخفي بين دموعها ما عجزتُ عن سؤالها عنه.
كانت "شام" تتحاشى النظر إلى عينيَّ، وكلما حدَّقتُ في زرقة عينيها، تغمضهما، وتقول لي ببراءة طفلة:
- هيا بنا نكمل الحلم على مفارش أسرَّتنا، وتحت وسائدنا.. هناك نُبعثُ أحياء.. هناك نُخلَّد كأيقوناتٍ مقدَّسةٍ.. هناك سأنجبُ لكَ وطنًا يشبهكَ.. شبابيكه تطلُّ على الحريَّة، وفسحته السَّماوية تزخر بأغانينا المفضلة.
- هل تذكر هديتي الأولى لكَ.. مجموعة أغاني إديث بياف الأثيرة لديكَ؟.
في هذه اللحظة التي كنت أستعيد فيها حواري مع "شام"، علا صوت إديث بياف وهي تغنِّي
La vie en rose
آه! كيف يختلط الماضي بالحاضر لمجرد أن تسمع أغنية.. أغنية نقلتني بكل خيباتي، وانكساراتي إلى حضن "شام" الدافئ.. إلى رائحة الليل الحالك في شَعرها.. إلى صوتها وضحكتها.. إلى عنادها وهي تمعن في تقبيلي وكأنني سأغادر إلى غير رجعةٍ.. إلى همسها وهي تلعق شهوتي على جسدها.
يا لك من شرير أيها اليعقوب اللعين! وضعتَ على جرحي النَّازف ملحًا.. كيف سأسامحك وأنتَ تغرز في خاصرة شوقي إليها كل سكاكينكَ وخناجركَ!
استقر الوهم الجميل في رؤوس الشاربين بعد أن هدأ يعقوب، وعاد المقهورون إلى ملء كؤوسهم، ومتابعة ما فاتهم من أحلام بسبب تصرف يعقوب غير المسؤول، وعدتُ أنا أيضًا إلى بوَّابة العشق الأولى.. أخطف القبلات، واللمسات، وأحشو بها أكمام الذاكرة وجيوبها الواسعة؛ لأستعين بها على سجني الجديد بعد رحيل "شام" إلى السماء البعيدة.
الموتُ علاج ناجع لأمثالي، وحلٌّ مثالي للاجئٍ رحل عنه الوطن/شام/ وتركه يتخبطُّ بذكرياته.
ملأت كأسي الأخير وتجرعته دفعة واحدة لأجد سببًا مقنعًا أغادر به البار.. عانقتُ "شام"_ وهمي الأول والأخير_ ومسحت دموعها المنهمرة على وجنتيَّ، على وعدٍ منى بالعودة إليها غدًا، وما يليه من قادمِ الأيام.
ألقيت نظرة أخيرة على الذين يمارسون أوهامهم ويشبهونني في إدماني عليها.. جميعنا نرسم أوطانًا تشبهنا، نلجها مرفوعي القامات، وعند بزوغ الفجر نمحوها، بظهورٍنا المحنيَّةٍ، ثم نطوي الليل تحت إبطنا، ونختفي في زحمة الضوء.
الدخان كثيف، روائح التبغ والمشروبات الكحولية، وموسيقا الجاز تملأ الأجواء في البار الذي يقصده كل مساء سكان الحي المجاور، والذي يفيض الفقر عن حاجة قاطنيه، لكنهم لا يتوانون عن طقوسهم مهما جاعت بطونهم، يجدون في الخمر الرديء الذي يقدمه لهم يعقوب، ملاذًا آمنا، وهروبًا من أرقٍ سيُلقي القبض على غفوتهم فيما لو لم يأتوا إليه، مُحمَّلين بكوابيس ليلتهم السابقة حين يتعذَّر عليهم المجيء بسبب شحِّ النقود في جيوبهم.
يعقوب لا يشرب الخمر لكنه يبيعه لهم، يشترون منه لحظات اللذةِ، والشَّبق وهم يراقبون فتيات الليل ينادمن زبائنهن.
في الزوايا المعتمة من البار تتشابك الأيدي وتكثر الهمهمات والوشوشات.. ثم فجأة تعلو الضحكات الهستيرية، معلنةً عن بدء طقوس الثمالة في محاولاتٍ يائسةٍ لخلع أثواب ذواكرَ مثقلةٍ بالعفن، وممتلئةٍ بثقوبٍ لم ينجح النسيان في رتقها.
كنت من روَّاد البار الدائمين، أتأبَّط خيبة أيامي الماضية وأعاقرها خمرة يعقوب الرديئة، ثم أجلسها على حضني وأداعبها كطفلةٍ صغيرةٍ لم أفلح في إنجابها يومًا.
تصدح الموسيقا في الأجواء، وتبدأ القدود المياسة بالرقص والعناق الحار على أنغام أغاني الستينيات التي كان يعقوب شغوفًا بها، وهذه هي الميزة الوحيدة التي جعلتني لا أنقطع عن البار رغم كل سيئاته.
هنا في هذا الجو الخانق أستعيد بعضًا منِّي بعد عدة كؤوس، وتبدأ رحلة العودة إلى الوراء، إلى "شام" الممشوقة القوام، ونهديها العارمين حين يعانقان زرقة السماء، كيف يجتمع رخام صدرها وقبة السماء؟
لطالما سألتها عن السر في ذلك، كانت تجيبني بقبلة وعناق.. تضع سبابتها على شفتيَّ لتزيد من شهوتي وأنا أطوِّق خصرها الذي يشبه مدنًا بكرًا لم تطأها أقدام الحرب، تُلقي برأسها الجميل على كتفي وجسدها البض يلتصق بجسدي لنشكل بذلك لُحمةً وطنيَّةً لا تمتُّ بصلةٍ لتلك اللحمة التي يتداولونها في النشرات الإخبارية والصحف المحلية.
"شام" تذوب بين ذراعي وأغنية إديث بياف La foule
تطوينا تحت جناحيها، هربًا من كلِّ الشِّعارات التي أتخموا بها عقولنا القاصرة.. الجسد هو الوطن الأمُّ، منه اشتقَّتِ الحياة اسمها وعنوان سكنها.
يبدأ الآن دور يعقوب في الشتم وكيل اللعنات على السكارى.. أصحو من رحلتي إلى الماضي وأربِّت على كتف يعقوب في محاولة مني لتهدئته، وإقناعه بأنه يتصرف مثل رجال السُّلطة مع الشعب، حين يقطع أعناق أحلامهم.. أو يئدها حيَّةً.. أو تحت التعذيب في أقبية الموت.
لم أتمالك نفسي وقلت له:
- دعهم في أحلامهم الوردية، ولا تمارس القمع معهم.. يكفيهم قمع رجالات الوطن.
يطأطئ يعقوب رأسه ويعود أدراجه إلى مكانه المعتاد بين زجاجات الخمر والكؤوس، ولا يغادرني إلا وهو يكرر سؤاله اللجوج:
- ألم تسأم من أحلامك؟، وترتفع ضحكته لتقطع صمت الجدران الحزين.
طلبت زجاجة أخرى لأكمل درب نزوحي إلى رحم الذكريات، وأطفئ حرائق مدينتي بأعقاب سجائري وكأنني أنتقم لها ولنفسي و"لشام".
"شام" ناشطة سياسية تدعم الأحرار وتدافع عن المعتقلين.. إنها فاكهة الجنة على الأرض، دخلت السجن مرَّاتٍ ومرَّات، ولم تتحدث معي عن معاناتها بين القضبان.. ولأنني أحترم صمتها، لم أسألها عن أي شيء.. تركت لها الأمر وأنا على يقين أنها ستفضي لي وتبوح بأدق التفاصيل حول تلك المرحلة التي تشاركناها، حين كانت داخل السجن.. وأنا كنت خارجه.
كيف لهذا القلب النابض بالحب والفكر النيِّر أن يُزجَّ به في أقبية التعذيب؟
كيف لهذا الحماس أن يدفن في رطوبة القهر؟
هذه الأسئلة ما فتئت تنخر تفكيري، إلى أن أُفرجَ عن "شام" ولم أصدق ذلك إلا حين رأيتها بكامل عنفوانها، وحزنها البهي تعانقتي؛ لتخفي بين دموعها ما عجزتُ عن سؤالها عنه.
كانت "شام" تتحاشى النظر إلى عينيَّ، وكلما حدَّقتُ في زرقة عينيها، تغمضهما، وتقول لي ببراءة طفلة:
- هيا بنا نكمل الحلم على مفارش أسرَّتنا، وتحت وسائدنا.. هناك نُبعثُ أحياء.. هناك نُخلَّد كأيقوناتٍ مقدَّسةٍ.. هناك سأنجبُ لكَ وطنًا يشبهكَ.. شبابيكه تطلُّ على الحريَّة، وفسحته السَّماوية تزخر بأغانينا المفضلة.
- هل تذكر هديتي الأولى لكَ.. مجموعة أغاني إديث بياف الأثيرة لديكَ؟.
في هذه اللحظة التي كنت أستعيد فيها حواري مع "شام"، علا صوت إديث بياف وهي تغنِّي
La vie en rose
آه! كيف يختلط الماضي بالحاضر لمجرد أن تسمع أغنية.. أغنية نقلتني بكل خيباتي، وانكساراتي إلى حضن "شام" الدافئ.. إلى رائحة الليل الحالك في شَعرها.. إلى صوتها وضحكتها.. إلى عنادها وهي تمعن في تقبيلي وكأنني سأغادر إلى غير رجعةٍ.. إلى همسها وهي تلعق شهوتي على جسدها.
يا لك من شرير أيها اليعقوب اللعين! وضعتَ على جرحي النَّازف ملحًا.. كيف سأسامحك وأنتَ تغرز في خاصرة شوقي إليها كل سكاكينكَ وخناجركَ!
استقر الوهم الجميل في رؤوس الشاربين بعد أن هدأ يعقوب، وعاد المقهورون إلى ملء كؤوسهم، ومتابعة ما فاتهم من أحلام بسبب تصرف يعقوب غير المسؤول، وعدتُ أنا أيضًا إلى بوَّابة العشق الأولى.. أخطف القبلات، واللمسات، وأحشو بها أكمام الذاكرة وجيوبها الواسعة؛ لأستعين بها على سجني الجديد بعد رحيل "شام" إلى السماء البعيدة.
الموتُ علاج ناجع لأمثالي، وحلٌّ مثالي للاجئٍ رحل عنه الوطن/شام/ وتركه يتخبطُّ بذكرياته.
ملأت كأسي الأخير وتجرعته دفعة واحدة لأجد سببًا مقنعًا أغادر به البار.. عانقتُ "شام"_ وهمي الأول والأخير_ ومسحت دموعها المنهمرة على وجنتيَّ، على وعدٍ منى بالعودة إليها غدًا، وما يليه من قادمِ الأيام.
ألقيت نظرة أخيرة على الذين يمارسون أوهامهم ويشبهونني في إدماني عليها.. جميعنا نرسم أوطانًا تشبهنا، نلجها مرفوعي القامات، وعند بزوغ الفجر نمحوها، بظهورٍنا المحنيَّةٍ، ثم نطوي الليل تحت إبطنا، ونختفي في زحمة الضوء.